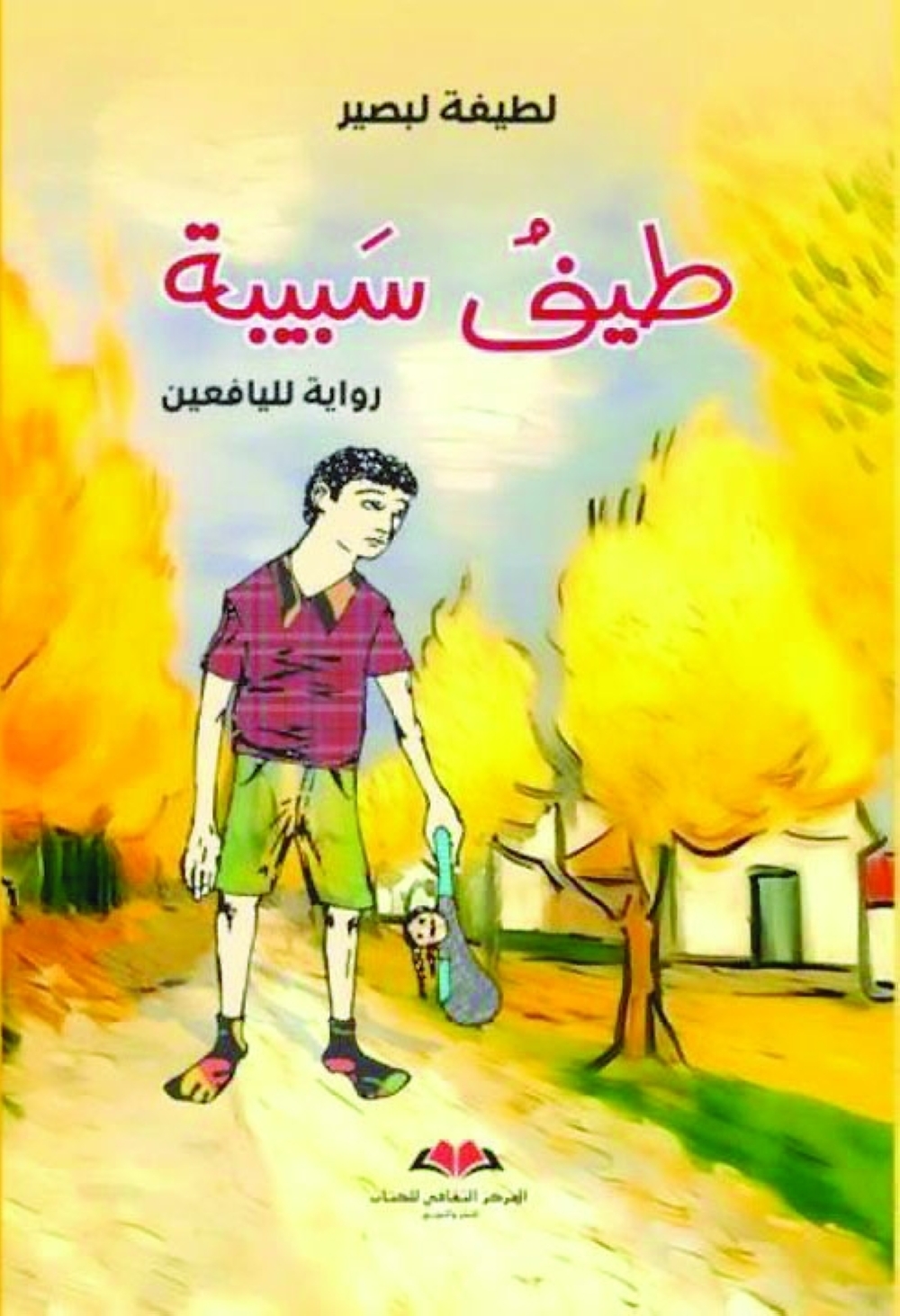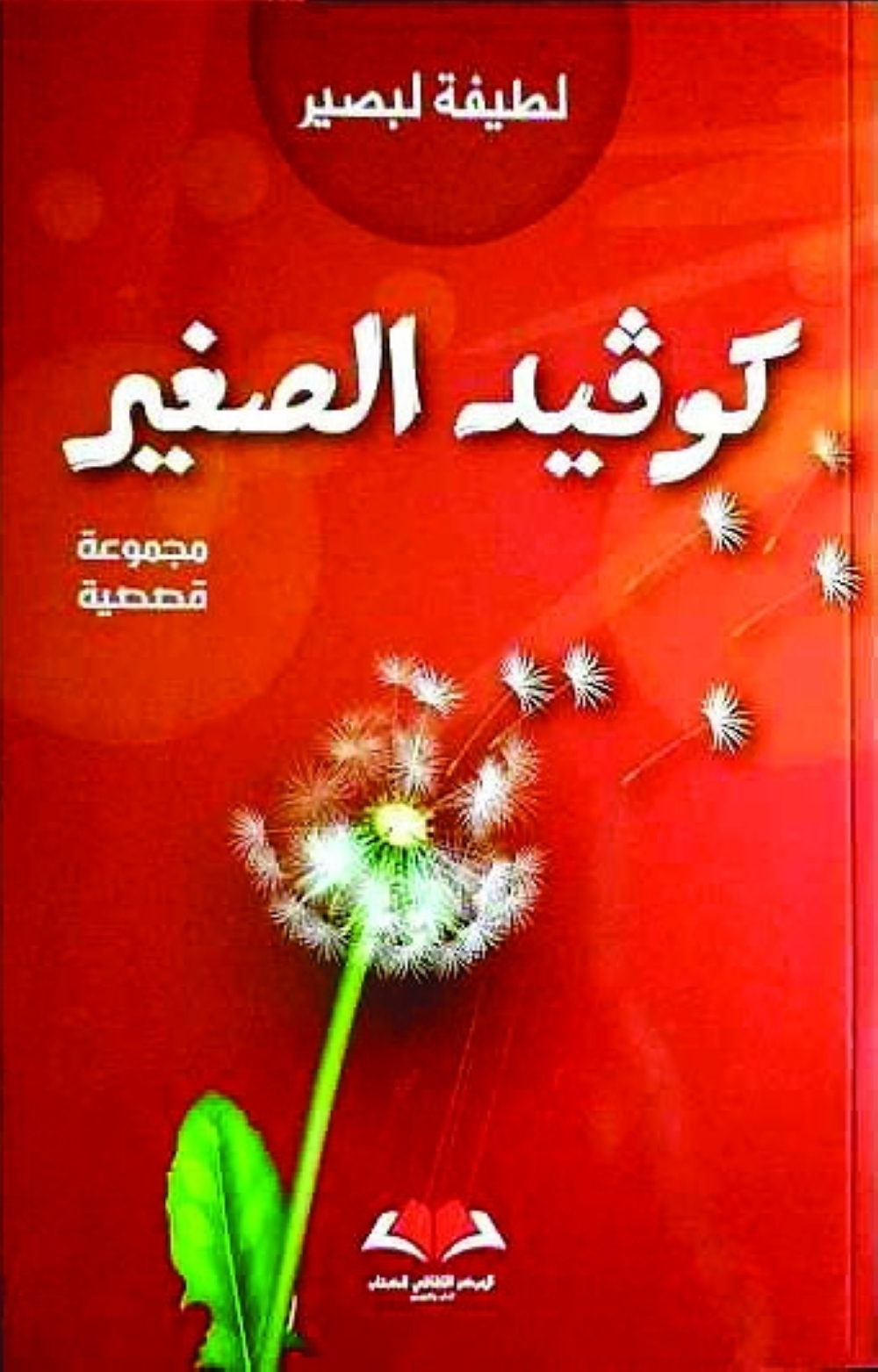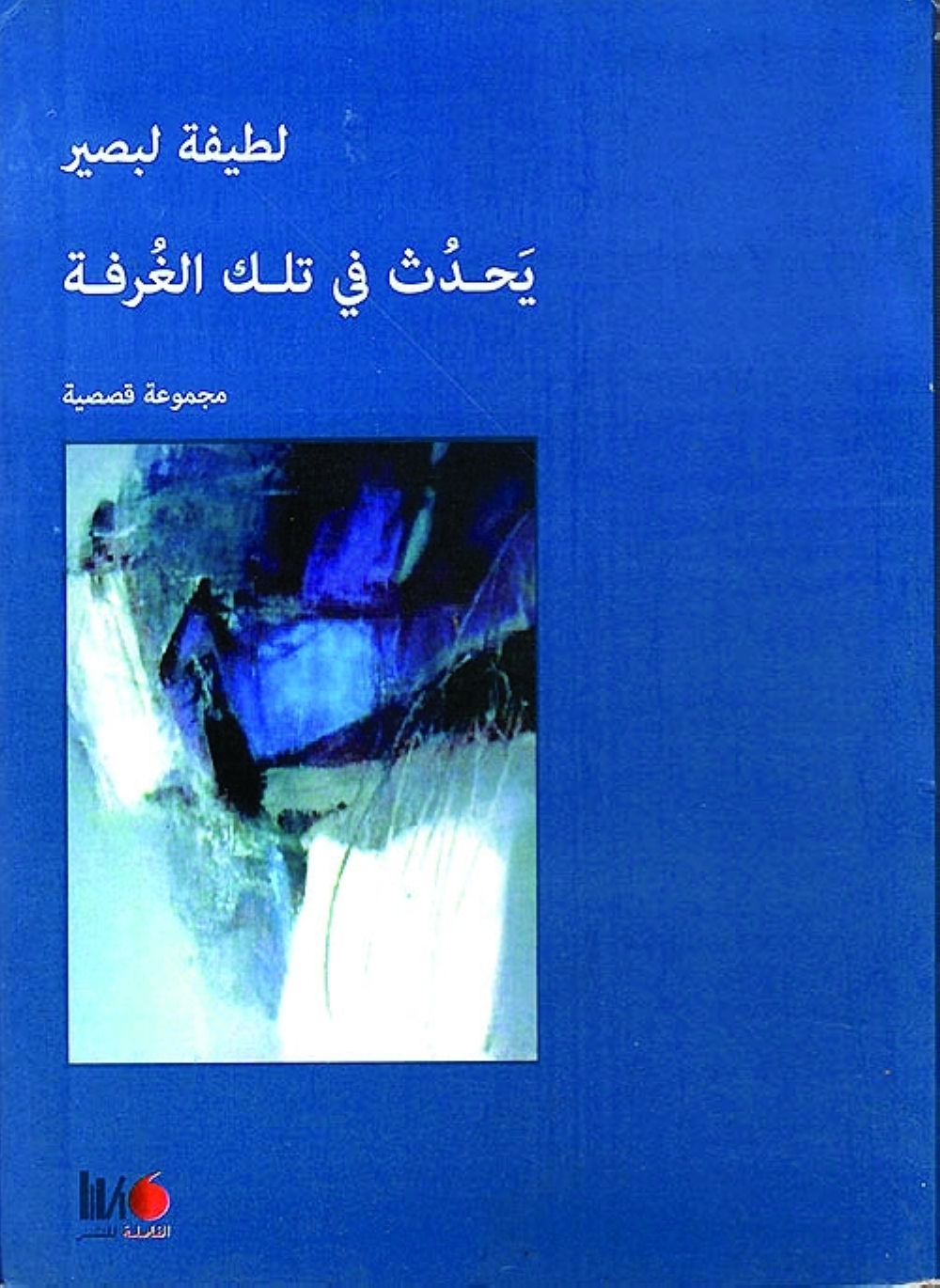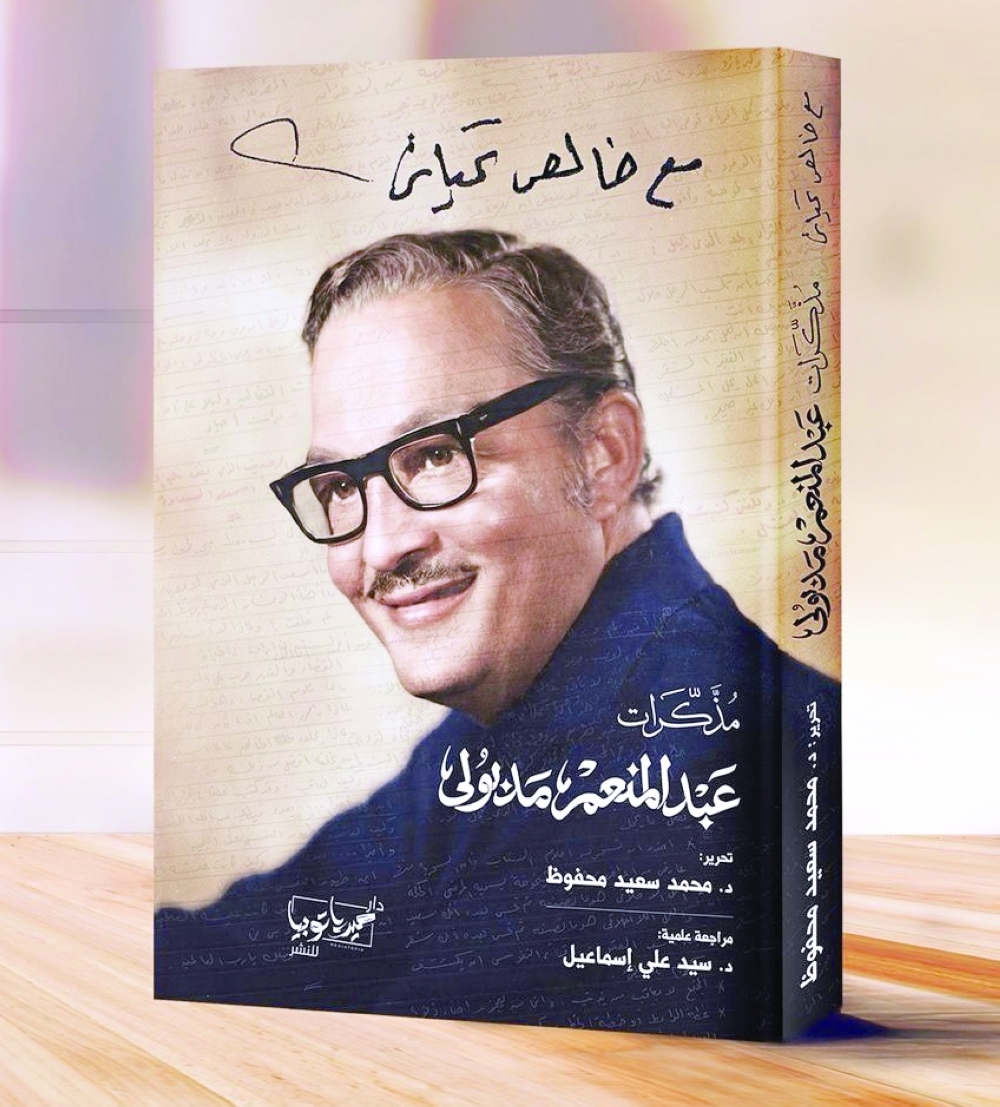حوار ـ فيصل بن سعيد العلوي
مؤكدة أنها تفكّر أكثر مما تُحكى -
الإبداع لا يتقدّم بالانتقال بين الأجناس -
الجائزة قد تقدّم الكاتب لكنها لا تصنعه -
السرد يبدأ من الإحساس لا من الحكاية -
تمثّل الكاتبة والباحثة المغربية الدكتورة لطيفة لبصير صوتا سرديا راكم مشروعه عبر مسارين متوازيين، الكتابة الإبداعية والاشتغال الأكاديمي، في تجربة تتقاطع فيها الأسئلة الجمالية مع الهمّ الإنساني والمعرفي، وجاء فوزها بجائزة الشيخ زايد للكتاب ليعيد فتح النقاش حول هذه التجربة وما تنطوي عليه من رهانات تتجاوز منطق التتويج إلى التفكير في القصة القصيرة والتلقي والجسد وحدود الأجناس الأدبية وعلاقة النص بزمنه، وفي هذا الحوار تقدم «لبصير» رؤيتها للكتابة متوقفة عند محطات أساسية في مسارها، ومقدّمة تأملاتها حول القصة القصيرة، وإيقاعها، وشروطها الجمالية، كما تتناول موقع الإبداع في مشهد ثقافي تحكمه السرعة والجوائز، حوار يقترب من جوهر التجربة السردية ويضع الكتابة في السياق الفكري والإنساني باعتبارها فعلا مفتوحا على القلق والمعرفة والتجريب.
كيف تغيّر الجوائز الكبرى -وأنتِ الحائزة على جائزة الشيخ زايد للكتاب- علاقة الكاتب بنصه أتمنحه طمأنينة متأخرة، أم تضعه أمام نوع جديد من القلق والمسؤولية تجاه ما سيكتب لاحقا؟
الجائزة في تقديري هي قبل كل شيء اعتبار رمزي، محطة يُسلَّط عندها الضوء على العمل، ليس لأنها تصادقه أكثر مما ينبغي، بل لأنها تفتح له أفقا جديدا من التلقي، ولا يمكن إنكار أن للجائزة أثرا عمليا في حياة الكاتب، لكن قيمتها الحقيقية بالنسبة لي كانت في نوعية القرّاء الذين وصلوا إلى العمل بعد الفوز، قرّاء مختلفين تماما عن الذين سبقوه، وقراءته صارت تُستقبل من زوايا لم تكن مطروحة من قبل. ما حدث مع رواية «طيف سبيبة» تحديدا أن الجائزة منحتها ضوءا آخر، لا لأن النص تغيّر، بل لأن المتلقي تغيّر... صار هناك نوع من الانبهار المسبق، وكأن الجائزة أضفت على النص شرعية إضافية، أحيانا أكثر مما يفعل النص بذاته، وهذا أمر إشكالي ومثير للتأمل في آن واحد، فأنا أؤمن أن لكل كتاب قدره الخاص مع قرّائه، ولا يمكن التنبؤ بمساره أو تثبيت قيمته سلفا، فالنص يُعاد اكتشافه في كل مرحلة عمرية، ويُقرأ بطرق مختلفة حسب أفق انتظار القارئ، وهو ما تقوله نظريات التلقي بوضوح... وهذا العمل تحديدا حظي بتلقٍّ خاص قبل الجائزة وبعدها لأنه عمل إنساني يتناول طيف التوحد، وقد كُتب من منطقة تجمع بين الفني والمعرفي والعلمي، اشتغلت عليه ميدانيا وبحثيا قبل أن يتحوّل إلى أدب، وكان الأدب هنا بمثابة مصفاة لكل هذا الخليط من التجربة والمعرفة، فالكتابة كانت مرهقة، لأنني حاولت الدخول إلى عالم الطفل المصاب بالتوحد، لا الحديث عنه من الخارج، بل نقل تصوراته للعالم كما يراها هو، وهي تصورات في كثير من الأحيان أكثر غرابة من الخيال نفسه. كثيرون سألوني إن كان ما كتبته متخيّلا، والحقيقة أن الواقع في هذه الحالات يتجاوز التخييل، وهذا ما جعل التجربة صعبة، لكن ضرورية، ومسؤولة أخلاقيا قبل أن تكون سردية.
في نصوصك تتقدم حالة الحدث ليس بقدر الحدث نفسه... كيف تُبنى القصة حين لا يكون الفعل هو محرّكها الأساسي بل ما يترسّب داخله؟
هناك قصص تقوم على الأفعال بشكل واضح، وقد كتبت هذا النوع من القصص في مجموعات عديدة مثل «رغبة فقط»، «ضفائر»، «أخاف»، «يحدث في تلك الغرفة»، «عناق»، «كوفيد صغير»، «محكيات نسائية»، وغيرها. بالنسبة لي لا توجد صيغة واحدة تُفرض على القصة، فلكل نص ميزانه وإيقاعه الخاص، وبعض القصص تحتاج إلى حركة كثيفة وأفعال متتابعة، ويكون الحاضر فيها متوترا ومتغيّرا باستمرار.
في المقابل، هناك نصوص أخرى بطيئة الحركة، ينشغل بناؤها بالحالة أكثر من انشغالها بالفعل، وهذا ما أميل إليه في تجربتي القصصية. ما يهمني ليس الحكاية في ذاتها، وإنما ما يظل عالقا منها بعد أن تنتهي، الأثر الذي تتركه في النفس، والوقع الداخلي الذي يصاحب الشخصية. لذلك أشتغل على العالم النفسي، على ما يترسّب في الداخل، وعلى ما يبقى من الحكاية حين تخفت أصوات الأحداث.
التفاصيل الصغيرة في كتابتك لا تعمل كزينة واقعية وتصنّف كآثار لما جرى خارج النص، متى تعرّفين التفصيل كضرورة سردية وليس خيارا أسلوبيا؟
هذا سؤال رائع.. ولم يُطرح عليّ من قبل، فأنا أفكّر دائما أن لكل نص قياسه الخاص في الحركة، وفي الفعل، وفي البوح، وكل قصة، وكل بطل، له ميزانه المختلف، خصوصا أنني أكتب أحيانا بضمير المتكلم المذكر، وأحيانا بالمؤنث، وهذا يفرض إيقاعا خاصا بكل نص.
لديّ مثلا قصة بعنوان «إيماء» كُتبت في زمن كورونا، وتدور حول بطلة اسمها مي، ومي، كانت تعاني من عطب في الحركة، جسدها رخو وحركتها محدودة جدا، وحين أصيب الآخرون خلال الجائحة بالإنهاك النفسي، بدت هي كأنها تستيقظ أو تنتعش، وهو أمر غير ممكن واقعيا، لكن الفكرة التي أردت إيصالها أن هناك أناسا قد ينهضون في الأزمات، فيما ينهار آخرون... اشتغلت على ضبط إيقاع الحركة داخل القصة، كيف تتحرك هي في اللحظة التي ينكسر فيها الآخرون، ثم حين يعود الآخرون إلى الفعل تنكسر هي، وكأنهم لا يستطيعون الالتقاء داخل إطار واحد للحركة، لذلك كان للقصة إيقاعها الخاص، تنغلق ثم تنفتح ثم تعود إلى الانغلاق، خصوصا في الليل، وهذا الإيقاع هو ما حكم بناء النص.
... إذن القصة القصيرة نتيجة موقف من العالم ولا تبدو أنها ابنة اقتصاد لغوي فقط، فما الذي تغيّره القصة القصيرة في طريقة التفكير وليس في طريقة السرد فقط؟
كُتب عن تجربتي في أحد المقالات النقدية التي أعتز بها كثيرا، وكان عنوانه «حين تفكّر القصة القصيرة»، وأنا أجد هذا العنوان معبّرا بدقة عمّا أشتغل عليه. في كل قصة أكتبها، مهما بدا فيها من أحداث، هناك فكرة في الأصل، لأن النص يبدأ عندي فكرة قبل أي شيء آخر. أحيانا تنشأ الفكرة من كلمة واحدة، ثم تكبر هذه الكلمة تدريجيا، وتتفرّع، وتصبح كأن لها عروشا وتشعّبات. أنا أشتغل كثيرا على الكلمة. لدي مثلا قصة بعنوان «الدعسوق»، والدعسوق حشرة لها حضور أسطوري، وردت في الأغاني الشعبية، ومعروفة بوصفها صديقة للفلاحين لأنها تقضي على حشرات المن، ولها أيضا تعددية في علاقاتها.. كل هذه الحمولة جعلتني أختارها بطلة للقصة، ولم أضع الكلمة في النص بشكل عابر، بل جاءت بعد بحث طويل على المستوى البيئي والجغرافي والسياسي والتاريخي، لأن كل كلمة عندي لها إيقاعها ودلالاتها... فالفكرة هنا تسبق السرد، وتحتاج إلى معرفة قبل أن تتحول إلى كتابة، فالقصة القصيرة عندي تفكّر أولا، ثم تتطوّر، وتتشعّب، ويصبح لها امتدادها الخاص داخل النص، وكأن الفكرة نفسها تنمو وتكتسب أياديها أثناء الكتابة.
الجسد حاضر في نصوصك ذاكرة حسّية أكثر من كونه موضوعا سرديا، كيف تكتبين الجسد دون أن يتحول إلى خطاب ودون أن تفقدي حساسيته الإنسانية؟
الجسد حاضر في كتابتي منذ المجموعة القصصية الأولى «رغبة فقط».. في تلك المجموعة كان الجسد يظهر كأحد أبعاد غياب التواصل بين الأشخاص، فالعلاقات بين الرجل والمرأة، أو بين الإنسان والعالم، كانت تقف عند حدود الرغبة ولا تصل إلى التواصل، لذلك بدت متعثرة ومتوترة. كانت تلك تجربتي الأولى قبل نحو ربع قرن، وكان الجسد جزءا من هذا الانسداد الإنساني.
بعد سنوات عدت إلى هذا الاشتغال من زاوية أخرى في المجموعة القصصية «عناق»، وهي المجموعة التي وصلت إلى القائمة النهائية لجائزة الشيخ زايد عام 2013، في دورة حُجبت فيها الجائزة.. كان ذلك بالنسبة لي إحساسا بأن العمل ترك أثرا ما في القراءة وفي التلقي. وفي «عناق» حاولت البحث عن كل سبل العناق الممكنة في العالم، وليس العناق بين رجل وامرأة فقط، وقد اشتغلت على فكرة العناق بين الإنسان والأشياء، بينه وبين الحواس، بينه وبين الماضي، وبين الماضي والحاضر، حيث يحدث نوع من التواشج.
العناق في هذا السياق لا يقتصر على العلاقة الجسدية المعروفة، بل يمتد إلى العلاقات الإنسانية في الأسرة والمجتمع، وحتى في سياقات الحروب. الجسد حاضر في كل ذلك، لكنه لا يظل محصورا في الجانب الحميمي المتداول، بل يتشكّل في صور أخرى، ويذهب إلى علاقات أوسع وأعمق، تجعل الجسد جزءا من التجربة الإنسانية الكاملة وليس مجرد موضوع سردي محدود.
كيف تحافظين على التوتر الخلاق بين المعرفة النظرية وحرية النص (كونك تجمعين بين البحث الأكاديمي والممارسة الإبداعية) دون أن يطغى أحدهما على الآخر؟
الأمر صعب فعلا، ودائما أقول إن جانب المبدع في داخلي هو الذي يغلب في النهاية على الجانب النظري. أنا اشتغلت طويلا في النقد، وأصدرت أعمالا نقدية، لكن حين تتاح لي فرصة الكتابة الإبداعية أبدأ بالإبداع أولا. ومع ذلك، لا يمكن فصل الكتابة عن خلفيتها المعرفية، فهناك دائما أثر نظري يرافق النص من دون قصد، مهما حاولتُ تجاوزه.
الكتابة عندي تبدأ في كثير من الأحيان كحالة من التدفق، المشاعر تتدافع، وتتجمع لتكتب، ويبدو النص كفيض من أشياء لا متناهية. في هذه اللحظة أحاول أن أضبط هذا التدفق بالأسلوب وبالتقنية. أكتشف أنني، من دون وعي مباشر، أستحضر ما تعلمته حول كيفية بدء النص، وحول الجملة الأولى تحديدا. هذه الجملة الافتتاحية تهمني كثيرا، لأنها تخاطب القارئ منذ اللحظة الأولى، وتخلقه داخل النص، وقد تمسك به أو تتركه خارج التجربة.
أشتغل على الجملة الأولى كثيرا، حتى وإن بدت بسيطة، لأنها تحمل إيقاع النص كله، وتؤسس لإشكاليته وأطروحته، وتحدد كيف سيتحرك لاحقا من دون أن يخرج عن هذا الإيقاع. هنا تظهر فائدة المعرفة التقنية والنظرية، فهي تمنحني أدوات للضبط لا للهيمنة. وفي الوقت نفسه، أؤمن أن الإبداع يتكوّن أيضا بالتراكم، بتراكم القراءات. كثير من المبدعين لم يشتغلوا نظريا بشكل مباشر، لكن قراءاتهم المستمرة بنت لديهم وعيا نظريا غير معلن، يتسلل إلى الكتابة من دون أن يفرض نفسه عليها.
كثيرا ما تُقرأ كتاباتك ضمن سياق «الكتابة النسائية»، إلى أي حد تشعرين أن هذا التصنيف يفتح أفق القراءة، وإلى أي حد يفرض عليها سقفا مسبقا؟
أنا اشتغلت طويلا على السيرة الذاتية النسائية في العالم العربي، وكانت موضوع أطروحة أكاديمية، ثم تحوّل هذا الاشتغال إلى كتاب صدر عن المركز الثقافي. لهذا ربما يتوقّع بعض القرّاء أن كل ما أكتبه يندرج تلقائيا ضمن خانة الكتابة النسوية، بينما أنا لا أكتب بهذه الطريقة. من يقرأ تجربتي جيدا يدرك أنني أكتب عن المرأة كثيرا، لكنني أكتب أيضا عن الإنسان، والنصوص نفسها تشهد على تنوّعها واختلاف اشتغالاتها، والانشغال بالسيرة الذاتية النسائية جاء من سؤال معرفي محدّد: لماذا نميّز السيرة الذاتية النسائية؟ هل هناك أسلوب خاص تكتب به المرأة سيرتها الذاتية؟ الدراسة التي اشتغلت عليها كانت طويلة، وانتهت إلى أن هناك فعلا طريقة تعبير خاصة، ولغة خاصة، وصوغا مختلفا تسوق به المرأة تجربتها في النصوص السيرية والروائية.. ففي بعض النصوص قد لا نستطيع تمييز هوية الكاتب، هل هو رجل أم امرأة، لكن في حالات كثيرة لا يمكن الكتابة إلا من داخل التجربة الجسدية والنفسية الخاصة بالمرأة.
كتبت عن مراحل مثل الحمل والولادة، عن إحساس الجسد بالولادة، عن المتاعب والتحوّلات النفسية المصاحبة لها، وهذه أمور مهما بلغ الخيال لا يمكن للرجل أن يكتبها بنفس المقدار من الدقة أو بنفس الإحساس. هناك نصوص اشتغلت فيها على هذه الحالات، لأنها مرتبطة بتجارب نفسية وجسدية تعبّر بها المرأة الكاتبة عن ذاتها. المرأة الكاتبة هنا ليست المرأة العادية، فالصوغ في الكتابة يكون مختلفا، أكثر تركيبا وحساسية... وأنا أرى الأمر من الجهة المقابلة أيضا، فلا أستطيع أن أكتب عن مواجع الرجل، وعن تحوّلاته العمرية، وعن انتقالاته الوجودية بنفس العمق والدقة الشعورية التي يكتب بها هو عن نفسه. قد أكتب، نعم، لكن الإحساس هنا يظل عنصرا حاسما، وهو جزء من هذا النقاش... ولهذا لا يزعجني أن تُقرأ كتابتي ضمن هذا الأفق، لكنني أتحفّظ على الفهم الضيّق للنسوية في سياقنا، ما يُسمّى بالخطاب النسوي عندنا غالبا ما يُختزل في تصورات ضيّقة، وفي مواقف تقطع المرأة عن طبيعتها الإنسانية، عن الأمومة، عن الجسد، عن علاقتها بالرجل. هذا النوع من الطرح لا أتبنّاه، بل أنتقده، أرى أن المرأة عالم إنساني كامل، يحتاج إلى عالم آخر يوازيه ويتواشج معه، وأن الاكتمال لا يتحقق إلا في هذا التفاعل، لا في القطيعة أو في التصادم، بل في العلاقة التي تشبه الشجرة، جذور واحدة وأغصان متعددة.
في زمن تسارع النشر وتحوّل الكتابة إلى استجابة فورية، كيف تحمين نصك من الاستعجال، وتمنحين التجربة حقها في النضج والاختبار؟
أصبحت كثير من النصوص اليوم خاضعة لفكرة الاستعجال، وغالبا يكون الدافع هو المرور السريع نحو الجائزة، وهذا في تقديري أمر معيب. كثير من هذه النصوص ليست ذات شأن حقيقي، لأن الهاجس لم يعد الكتابة نفسها بل الفوز. أنا أؤمن أن الإبداع يأتي أولا، ثم قد تأتي الجائزة لاحقا إن جاءت. النص لا يُكتب لأنه موجَّه إلى جائزة، بل يُكتب لأنه يفرض نفسه، لأن هناك شرطا ذاتيا يدفع إلى الكتابة. يجب أن يكون لدي ميل نفسي تجاه ما أكتب عنه، حتى لو كانت الشخصيات التي أكتبها مختلفة عني.
لا يوجد تباعد حقيقي بيني وبين الشخصيات التي أختارها. هي ليست أنا، لكنني اخترت الكتابة عنها لأنها أوجعتني في شيء ما، لأنها لامست منطقة أشعر أنني قادرة على التعبير عنها. هناك مناطق معتمة في النفس تعود إلى الطفولة، تعود لتتشكل من جديد، وتخضع في لحظة ما لشرط الكتابة. أحيانا نكتب عن أشياء قادمة من زمن بعيد، دون أن نعرف لماذا تعود في هذه المرحلة تحديدا من العمر أو التجربة، لكنني أعتقد أن كل ذلك يخضع لاختبارات نفسية وذاتية، وللتكوين الشخصي، ولرغبتي في التعبير عن حالات أشعر بها من دون وعي كامل... ولهذا السبب أكتب في أغلب نصوصي، وربما في معظمها، بضمير المتكلم. هذا الضمير أشعر أنه الأقرب إليّ، حتى حين يكون المتكلم رجلا. ضمير المتكلم يمنحني هذا القرب، ويجعل الدخول إلى التجربة أكثر كثافة.
أستحضر هنا ما قاله فيليب لوجون، إن الأنا عائلة كبيرة تضم الأنا والأنت والهو، وهذا التصور يريحني في الكتابة. من خلال ضمير المتكلم أستطيع أن أعبّر عن شخصيات كثيرة، حتى لو كانت مختلفة عني، فأنا مغرمة بهذه الشخصيات، وأشعر دائما أن هناك حاجة إلى نوع من الامتلاء، وهذا الامتلاء لا يتحقق إلا من خلال هذا القرب. الدخول إلى عوالم الضمير الشخصي، والكتابة من داخله، يسمح لي بالوصول إلى العالم الداخلي لكل شخصية. أشعر أن الشخصية تظل ناقصة ما لم تُكتب من هذا الباب، باب القرب النفسي والإنساني الذي يمنحها حقها في النضج والاختبار.
في ظل هيمنة الجوائز الروائية، اتجه بعض كتّاب القصة إلى كتابة الرواية باعتبارها أفقا أوسع للاعتراف والانتشار.. هل ترين هذا الانتقال تطورا طبيعيا في المسار الإبداعي أم أن لكل جنس منطقه وشروطه التي لا تُقاس بالجوائز؟
حين يكتب القاص رواية فهذا ليس أمرا مستغربا، لكن حين يتحوّل الشاعر إلى روائي فالأمر يختلف، وهذا لا يعني أنه غير ممكن، بل إن أي كاتب يمكنه أن يكتب في جنس آخر، ويمكن أن يكون مبدعا فيه إذا تحققت شروط الكتابة.. الإبداع في النهاية يُقاس بالنصوص نفسها، وبمدى اكتمال شروطها، لا بالانتقال في حد ذاته، والانتقال ليس قيمة بحد ذاته، ولا يعني بالضرورة تطورا، ولا ينبغي أن يُنظر إليه بهذه الصورة التراتبية.
أنا شخصيا لدي نصوص روائية كتبتها منذ زمن طويل، لكنها لم تصدر.. لم أتسرع يوما في نشرها، وما زالت موجودة عندي، بعضها غير مكتمل نسبيا، لكنها حاضرة، كتبت لفترة طويلة ولم أشعر بالحاجة إلى أن أتحول إلى الرواية... فالقصة القصيرة ما زالت الجنس الذي لا أتوقف عن الكتابة فيه، لأنه يغريني كثيرا، ويمنحني قدرة على تكثيف الحالات والمواقف في نص قصصي، وهو أمر ليس سهلا كما يُتصوَّر، وهناك تصور شائع يعتبر القصة القصيرة تمرينا صغيرا على رقعة ضيقة تمهيدا للانتقال إلى رقعة أوسع، وهذا تصور غير دقيق. القصة القصيرة من أصعب الأجناس الأدبية، رغم حظها المتعثر في الجوائز، وفي النقد، وحتى في التنظير.. المشكلة أن القصة القصيرة لا تمتلك نظرية خاصة بها، وغالبا ما تُقرأ وتُحلَّل بأدوات نظرية الرواية، وهذا يظلمها، لذلك للقصة شكلها المختلف، ومنطقها الخاص، ولو كانت لها نظرية مستقلة تُقرأ من داخلها، لأُعيد الاعتبار إلى صعوبتها وفرادتها بوصفها جنسا قائما بذاته، لا مرحلة عابرة نحو جنس آخر.
.. ولكن للأسف هناك من الكتاب لا يقيسون النصوص بـ «الإبداع» بقدر الرغبة في الجوائز وهذا أمر واقع يحدث؟
.. ولكن أيضا التاريخ ذكي، وله قدرة عالية على الغربلة، فكثير من الأعمال تُكتب وتُسوَّق وتُحاط بضجيج إعلامي كبير في لحظتها الأولى لا تلبث أن تنطفئ، لأن ما حرّكها لم يكن شرط الكتابة بل ظرفها... لذلك الزمن كفيل أن يفرز ما كُتب بدافع داخلي صادق عمّا كُتب استجابة للضوء العابر.
.. أتعتقدين أن الجائزة فعلا تصنع مبدعا؟
الجائزة يمكن أن تقدّم كاتبا، لكنها يمكن أيضا أن تطفئه، هناك كتّاب كثيرون، بعد حصولهم على الجائزة، انطفؤوا أدبيا، ولم يعودوا يكتبون أو يبدعون، وكأن تحقيق الجائزة منحهم إحساسا بالاكتفاء أو الاكتمال، بينما المبدع الحقيقي يعيش دائما إحساس عدم الاكتمال، وقلقا داخليا، ولا يستطيع أن يسير في العالم من دون هذا القلق. هذا القلق هو ما يغذّي الإبداع ويجعله مستمرا.. لذلك أنا أعتقد أن الجائزة لا تصنع مبدعا أبدا، إذا لم يكن الكاتب مبدعا في الأصل، فلن تمنحه الجائزة أثرا دائما، وحتى لو حصل عليها فلن يبقى له أثر حقيقي.. فأثر الجائزة يزول، وينتفع في لحظة، ثم يتلاشى، بينما الذي يستمر هو الإبداع نفسه، هو الكاتب الحقيقي الذي يواصل الكتابة ويواصل القلق.
لدينا أمثلة كثيرة في الأدب العالمي والعربي. ميلان كونديرا، مثلا، كتب روايات ذات عمق فلسفي ونفسي استثنائي، مثل «كائن لا تحتمل خفته» و«الهوية» و«الخلود»، ولم يحصل على جائزة نوبل، ومع ذلك بقي واحدا من أكثر الروائيين تأثيرا وتقديرا، وفي السياق العربي، عبد الرحمن منيف بعوالمه الروائية، وبخماسيته، وحتى بنصوصه القصيرة مثل «حين تركنا الجسر»، التي كُتبت بلغة رمزية عميقة، لا يمكن تجاوز أثره أو مقارنته بسهولة بكثير ممن حصلوا على جوائز... وهناك أيضا كتّاب مثل غالب هلسا، روائي مهم جدا، لم يحظَ بالانتباه النقدي في حياته، ويُعاد اكتشافه اليوم بعد مرور زمن طويل... هذا يؤكد أن الزمن هو الحكم الأخير، وأن ما يبقى هو الإبداع الحقيقي، لا الجائزة، ولا الضجيج المصاحب لها.
أخيرا .. ما المساحة التي لم تدخل الكتابة بعد في تجربتك، لأنها تحتاج درجة أعلى من الجاهزية والإنصات؟
في الحقيقة هو سؤال صعب... أنا بطبعي أميل إلى المغامرة، وقد كنت مغامِرة حين كتبت نصي الأخير، خاصة على مستوى التخليل، وأشعر برغبة في المغامرة مرة أخرى. في الوقت نفسه أنا أشتغل الآن على إنجاز نص جديد من العيّنة نفسها تقريبا، مع اختلافات بطبيعة الحال. لكن، رغم ذلك، ما زالت هناك مناطق لم أجرؤ بعد على الخوض فيها بقوة.
الأسرة واحدة من هذه المناطق. لكل واحد منا أسرته، وعلاقته الخاصة بها، والعالم الروائي في جوهره مبني على روايات أسرية، أنا أؤمن أن المبدع هو في النهاية بناء أسري، وأقول دائما إن التوقيع ليس شخصيا بالكامل، التوقيع هو توقيع عائلي، لأنني أنتمي إلى عائلة تركت بصمتها على جلدي، وعلى تكويني. هذه المنطقة تظل معقّدة بالنسبة لي، ثقيلة، وأشعر أن الاقتراب منها يحتاج شجاعة خاصة. أتمنى أن أستطيع الكتابة عنها يوما ما، في اللحظة التي أشعر فيها أنني قادرة على تحمّل ثقلها.