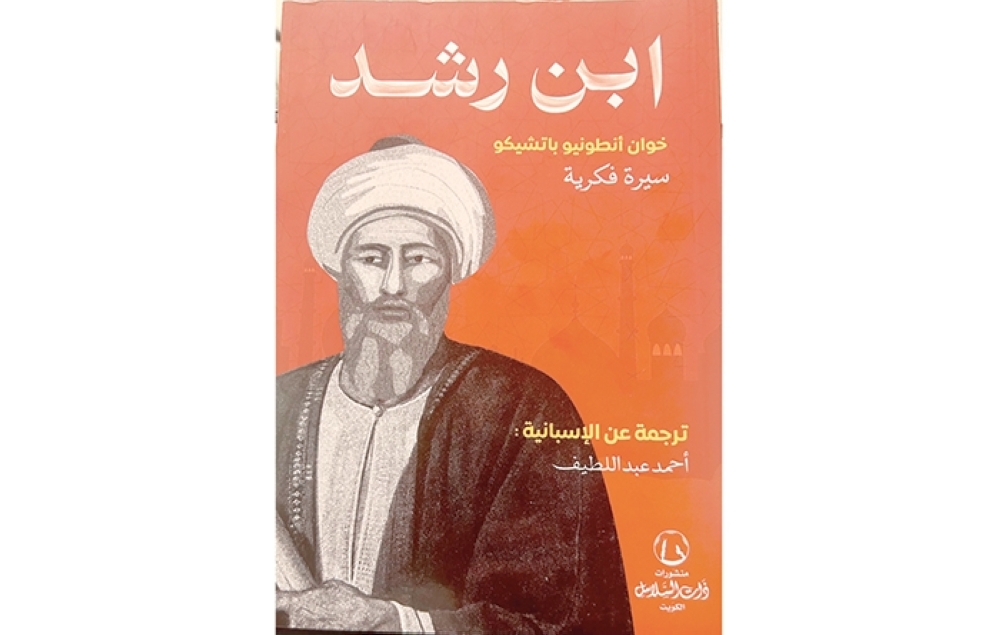الكتابة الشخصية وسط الضجيج
28 يناير 2026
28 يناير 2026
عاصم الشيدي -
كان الناس قديما يكتبون يومياتهم؛ كي لا يضيع يومهم. يكتبونها مثل من يضع حجرا صغيرا على حافة الطريق حتى يستطيع أن يجد لاحقا طريق العودة. تغير الأمر اليوم تماما؛ صار الناس يكتبون لأن الطريق نفسه يتغيّر سريعا تحت أقدامهم. تفلت اللحظة من بين يدي الناس، فيعيش الجميع بكثير من القلق. تبدو الحياة وكأنها تدار بيدٍ لا تُرى، تُبدّل الإيقاع كل أسبوع، وتعيد توزيع الأدوار كل يوم، وتطلب من كل فرد أن يشرح نفسه باستمرار: من أنت؟ ماذا تشعر؟ ماذا حدث لك؟ ولماذا ينبغي أن نهتم؟
هكذا صعد السرد الشخصي بوصفه استجابة واسعة لزمن يتعرف الناس فيه إلى أنفسهم عبر الشهادة أكثر مما يتعرّفون إليها عبر الأفكار. في كل هاتف حكاية، وفي كل حساب سيرة مُختصرة، وفي كل صورة تعليق ينوب عن فصل كامل. صار الفرد يُطالب بأن يصير «قصة» قبل أن يصير إنسانا. وإذا لم يقدم قصته، قد يبدو كمن لا يملك حق الوجود في سوق لا يصدّق إلا ما يُحكى.
من مكان ما في الخلف، يدفع القلق الناس إلى أنفسهم. قلق يأتي مثل ضجيج بعيد لا ينقطع لكن يمكن تلمسه من خلال التغيرات السياسية الحادة، والتقلبات الاقتصادية، والحروب التي بتنا نشاهدها على الهواء كما لو كانت مباراة. نتبينها، أيضا، عبر العلاقات التي تُدار بالرسائل المقتضبة. في مثل هذا المناخ، تصبح كتابة الـ«أنا» محاولة لترميم الصورة المبعثرة، فحين يتشظى العالم إلى أخبار قصيرة تصل في كل دقيقة، وفضائح سريعة تغتال مشاعرنا الإنسانية، لا يجد الكثير منا سوى نفسه كأرض ثابتة يأمن الوقوف عليها. حينها يروون ما حدث لهم في محاولة لفهم ما يحدث للعالم.
في السابق، كان الروائيون يرسلون أبطالهم إلى المجتمع حتى يعودوا بأسراره، الجديد في الكثير من النصوص التي نقرأها اليوم أنها تُرسل المجتمع إلى داخل الفرد. تترجم السياسة إلى قلق، والاقتصاد إلى اكتئاب، والحرب إلى أرق، والهجرة إلى حنين، والتمييز إلى جرح طويل. حين يكتب الفرد تجربته، فهو لا يكتب ذاته وحدها؛ يكتب أثر العالم فيها. لذلك تكتسب المذكرات واليوميات والمقال الشخصي قوة انتشار كبيرة. فهي تمنح القارئ نافذة على زمنه من زاوية قريبة، من داخل غرفة النوم أو في ركن في البيت أو من صمت المطبخ. كأن الحقيقة لم تعد تُقنع أحدا إلا إذا نُطقت على هيئة «أنا».
لكن وراء هذه الحميمية ما يستحق التدقيق. لقد أنشأت وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة على اختلاف منصاتها وأساليبها اقتصادا كاملا حول الاعتراف. كل شيء قابل للعرض، وكل شعور قابل للقياس. الإعجاب، والمشاركة، والتعليق، كلها تتحول إلى إشارات على القيمة. ثم يحدث التحول الأخطر: تتحول الذات إلى مشروع، والمشاعر والذكريات إلى محتوى. ويكتب الكثيرون يومياتهم وفي ذهنهم جمهور غير مرئي. يكتبون وهم ينحتون النسخة التي تصلح للعرض، لا النسخة التي تصلح للاعتراف.
يكتب كثيرون اليوم ليسمعوا صدى أسمائهم في الزحام؛ طلبا لاعتراف صغير، وخوفا من النسيان العام. وأحيانا يكون الهدف البحث عن مكان في هذا السوق الكبير من الضجيج.
وجاءت اللغة العلاجية لتمنح هذا النوع من السرد شرعية إضافية. أصبحت الكتابة مسارا للتعافي، وصار على الإنسان أن يسمي ألمه ويصفه. ليس سيئا أن يسمي الإنسان ألمه، لكن الخطر أن يتحول كل شيء إلى ملف علاجي، وأن يغدو العالم مجرد خلفية لأعراضنا. وفي هذه اللحظة يتغير السؤال الكبير، لماذا يحدث هذا لنا؟ لسؤال أصغر: كيف أشعر تجاه ما يحدث؟ الفارق بين السؤالين دقيق، لكنه يصنع أدبا مختلفا. أدب يقترب من الهمس، ويخشى البناء، ويكتفي بالومضة.
وعندما يتعلم الألم لغته، يصعد «أدب» الشهادات بوصفه قيمة أخلاقية. يصبح الصوت الفردي مهما في ظل الاستقطاب وسط الروايات الكبرى. الكثير من السرد الذاتي هو مقاومة صريحة ضد العنصرية، وضد الإقصاء، والعنف، والتهميش، والنسيان. حين يكتب أي إنسان اليوم تجربته، تجربته مع العنف أو الهجرة أو الظلم أو الخوف من المستقبل فإن ما يكتبه يتجاوز الأدب إلى الوثيقة. ويصبح السرد الشخصي بهذا المعنى نوعا من رد الاعتبار لمن لم يكن له صوت.
لكن هذا الاتساع في كتابة الذات يحمل تناقضاته. ففي اللحظة التي يصبح فيها الاعتراف فضيلة، يصبح أيضا سلعة. ويظهر سؤال لا يحب الأدب مواجهته: هل نكتب كي نضيء العالم، أم كي نحصل على مكان فيه؟ هل السرد الذاتي تحرير، أم شكل آخر من أشكال الانضباط؟ فحين يتعلم الناس أن يتكلموا عن أنفسهم وفق قوالب جاهزة: طفولة مؤلمة، صدمة، سقوط... يصبح النص شبيها بملف تعريفي يفقد قيمته وعمقه. وكأن السوق يريد من الألم أن يكون مرتبا، ومن التجربة أن تكون قابلة للتسويق، ومن الحياة أن تنتهي بخاتمة مريحة.
لهذا كله بدأت تظهر علامات تعب. القراء، مثل الكتّاب، يشعرون بأن «الأنا» وحدها لا تكفي. هناك عطش يعود إلى الرواية التي تمسك المجتمع بيدين قويتين، وتعيد ترتيب الفوضى دون أن تُزوّرها. عطش إلى روايات سوداء لا تتنبأ بالمستقبل فقط، بل تشرح الحاضر. لذلك يعود بعض الكتّاب الكبار إلى الواجهة في النقاشات الثقافية؛ لأنهم يملكون تلك القدرة على رؤية النظام داخل العبث. ليس الأمر حنينا إلى الماضي، لكن بحثا عن أدوات تُقاوم التآكل الداخلي البطيء الذي يصنعه سيل المعلومات.
في هذه النقطة تتبدّى المفارقة: ولد السرد الشخصي من القلق، ثم صار في بعض حالاته جزءا منه؛ لأنه حين يهيمن، يضع الفرد في مركز العالم على نحو مرهق. يجعل الإنسان يحمل على كتفيه عبء تفسير كل شيء. ويغريه أن يختصر المجتمع في تجربة، والتاريخ في لحظة، والسياسة في مزاج. وفي المقابل، هناك كتابة شخصية تُنجز عكس ذلك تماما، تستخدم الذات كبوابة لا كسجن. تحاول هذه الكتابة أن تُري القارئ كيف يعمل العالم داخل التفاصيل الصغيرة. كيف يمكن لغلاء المعيشة أن يظهر في ثلاجة شبه فارغة، وكيف يمكن لخطاب كراهية أن يغير نبرة شارع كامل.
الرهان إذن ليس على طرد السرد الشخصي، بل على انتشاله من سطحه. أن يعود الكاتب إلى الحرفة القديمة لتحويل التجربة إلى معرفة. وأن يكتب «أنا» وهو يرى «نحن» خلفها. وأن يتذكر أن القصة الشخصية لا تكتمل إلا حين تتجاوز صاحبها. حين تصبح مرآة لا قناعا.
ربما لهذا السبب تحديدا يظل الأدب، رغم كل شيء، أبطأ من الأخبار وأصدق منها. الأخبار تقول ما حدث. الأدب يقول ماذا فعل ما حدث بنا. وفي هذا الزمن المتخم بالقلق، لا يكفي أن نعرف الوقائع؛ نحتاج أن نفهم أثرها على أرواحنا. والسرد الشخصي أحد الأجوبة الممكنة، بشرط أن يخرج من شاشة الهاتف إلى الشارع، إلى قلب المجتمع دون أن يفقد دفء اليد التي تكتبه.
عاصم الشيدي كاتب ورئيس تحرير جريدة عمان