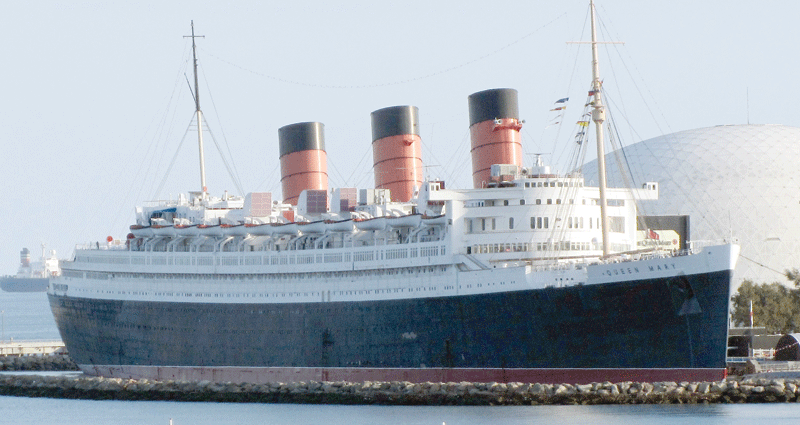
يوميات: «كوين ميري»، وأهلي في السويق والمصنعة
عبدالله حبيب -
هذه الحلقة من اليوميات مهداة بكل الفخر والاعتزاز من ذاكرة عنيدة لا تنام وليالٍ شرسة لا تنقضي إلى العزيز خليفة الرحبي.
السبت، 28 يوليو 2001، لوس أنجلوس، كاليفورنيا:
البارحة، في الظهيرة الصيفية الحارقة في مسقط، في مشهد ضبابي خلفيته فندق الإنتركونتينتَل أو الفندق الذي كان يدعى «الخليج»، (هكذا استدعي اسمه في ذاكرتي فأنا لا أحب اسمه الجديد «كراون بلازا»، الذي يليق أكثر بمرحلة العولمة): حضور معظم «شلَّة النادي الأهلي» الذين ظهر منهم الشهداء والذين ما بدَّلوا تبديلاً، ولكن انبثق بجلاء نوراني باهر خمسة من أكثر من خلق الله جوهرية، ورفاقيَّة نبيلة، وأصالة مستعصية على صدأ الزمن: سالم علي أبو طفول، عبدالله عبيد، خليفة الرحبي، علي السيابي، صالح العامري [وهو شخص آخر غير الشاعر والإعلامي المعروف]. كنا في المشهد المرتبك نفكر في الذهاب إلى مكان ما من المرجح انه منتبذ آخر بعد ما يبدو انه خروجنا الاضطراري في اثر استفزاز كاد يصل مرحلة التشابك بالأيدي مع أحد التافهين، أو شجار وصل فعلاً حد التشابك بالأيدي مع أحد السفلة المعروفين لدينا والخافين على غيرنا ممن يأتون إلى المنتبذ للحديث عن النضال والجبهة وآفاقها بعد الهزيمة العسكرية وهم يحملون في جيوب «دشاديشهم» أجهزة دقيقة تفوق قدرتها قدرة آذان الجدران، ليطلبوا لنا الرَّاح قدحاً إثر مكيدة وكأننا تلاميذ في مدرسة غبائهم. أحدهم، حين صارت اللعبة مفضوحة أكثر مما ينبغي في دوران الرؤوس، لم نكتفِ بـ «شرشحته» وإفراغ ما في جعبته وجيوبه على الطاولة في المنتبذ نفسه فحسب، بل طاردناه جحفلاً مهيباً مكيناً إلى موقف السيارات. أما الإنجليز الأوغاد فقد كان نصيب أحدهم ان يستأثر برحلة بُرَاقِيَّة من القرم إلى لندن رأساً. وخالص الشكر يُزجى هنا إلى قوة الدفع فوق-النَّفثي بسرعة تفوق سرعة الصوت ألف مرة أسداها له «بُكْساً» محترماً أحدنا. كان هناك العنف اللفظي و/أو البدني الذي نمارسه على كل من لا نحبه ولا يحبنا، إضافة إلى الطرد المهذَّب أو الصريح في كل ليلة تقريباً، ديدننا دوماً.
حلمٌ ضبابيته تكرع من وقائع الفترة المريرة حين عدت إلى الوطن في نهاية 1983 وحتى غادرته من جديد في نهاية 1985. سنتان سفحتهما في منتبذ «الخليج»، وسفحت معهما الكثير من الأشياء التي لن تعود. أما الحلم فهو وفاء في اللاوعي للأوفياء وعياً وفي الوعي. أفقت من النوم/ الحلم و[...] في حالة شبه جَثْوٍ، ورعاية، وتأهب للطوارئ بقربي. قالت لي مبتسمة: «أنا من شكل تمددات وانقباضات وجهك عرفت انك تحلم، لكنك لا صرّيت عَ أسنانك ولا صرخت. واضح انه كان حلم حلو ما كابوس. هاه، قول لي: لا يكون حلمت بوحده حلوه غيري»؟. احتضنتها وقلت: «لا، انتي محَّد أحلى منك». وقلت في نفسي: يا سالم علي أبو طفول، وعبدالله عبيد، وخليفة الرحبي، وعلي السيابي، وصالح العامري: شكراً لهذه الزيارة.
الأحد 29 يوليو 2001، لوس أنجلوس، كاليفورنيا:
ذهبنا –[...]، تغريد، نزار، ليل، وأنا – إلى مدينة «لونج بيتش»، حيث زرنا «المَرْبى المائي»: هكذا نجد ترجمة “aquarium” في «المورد الحديث». لكن هذه ترجمة تبعث على الريبة والشبهة؛ فـ«المَرْبى» تحيل إلى «التربية» (كي لا أقول التربية والتعليم) - «تربية الأسماك» في هذه الحالة. وهذا صحيح تماماً في حالة هذا «المَربى» ومثلائه من النظراء الكبار خاصة. بيد ان مهمة الـ “aquarium لا تقتصر على «تربية» الأسماك فحسب؛ بل يتعدى الأمر ذلك ليصبح تَتْحيفاً لأدوات بحرية غابرة، وتوثيقاً «مادياً» لما كان مجرد ذكر «شفاهي» في الذاكرة البحرية، إضافة إلى بيع المأثورات والمقتنيات البحرية (على شاكلة المتاحف التي تبيع لك نماذج مصغرة أو منسوخة من محتوياتها المادية والتشكيلية مثلاً). ومن هنا فإنني أعتقد أن «المتحف المائي» أو «المعرض المائي» في ضادنا أكثر دقة واستيعاباً لمفردة “aquarium”.
في الـ “aquarium” أعجبتني كثيراً قناديل البحر، وتَنَانينِه، والأسماك السَّامة ذات الألوان الزاهية (الكائنات السَّامة كالبشر وشبهائهم زاهية الألوان دوماً). كما حاولت ما في وسعي التعرف إلى الأسماء الأجنبية للأسماك المألوفة لدي من ذاكرتي «المجزيَّة» البحرية. لكن هذا ليس أقل من حماقة كبيرة؛ فالأسماك حتى وان تشابهت في الشكل لا تنتمي إلى نفس السلالة أو العائلة بالضرورة؛ فأصول الأسماك المحيطيَّة، أو النهريَّة، أو البُحَيريَّة تختلف تماماً عن سيرورة وصيروة الأسماك الخِلْجانيَّة. ولا تستطيع أبداً أن تتظاهر بالذكاء والفطنة في الـ “aquarium” في «لونج بيتش» فتصرخ مفاخراً بغبائك: أه، هذه هي «الحلواياه» في بحر مجز الصغرى.
لكن أشد ما أحزنني في زيارة الـ “aquarium” هو أن كل تلك الكائنات البديعة والجميلة سجين؛ فحتى أسوُد البحر -- التي أكنُّ لها قدراً لا بأس به من الاحترام والتقدير - محشورة هنا في صناديق زجاجية تحتوي على مقاربة سياحية زائفة لبيئتها الطبيعية، ومعروضة فرجة للبهائم البشرية الزائرة. يستطيع الإنسان أن يستولي على كل شيء، وأن يروِّض كل الأشياء، وكل المخلوقات، لكنه لا يستطيع أن يُرَوِّض نفسه أبداً.
كان كل شيء مما شاهدتُ وما تأملتً فيه يؤهلنا لغداء شهي من السمك المشوي. غير أني صدمت أن قائمة طعام الـ “aquarium” لا تتضمن مأكولات بحرية باستثناء وجبة أطفال. لا شك أن هذه نسخة متطرفة من الـ PC اللعين [الصَّوابيَّة السياسيَّة: political correctness]؛ فمن غير الإنساني مطلقاً بالنسبة للأمريكان رقيقي القلوب ومرهفي المشاعر لدرجة انهم يعيثون قتلاً في أرجاء المعمورة - كما في فيتنام وغيرها -- أن يأكلوا تلك الكائنات اللطيفة التي استمتعوا بمشاهدتها توَّاً وهي تسبح مَرِحَةً جَذِلَةً في الأحواض الزجاجية الملونة. يمكن لهم أن يفعلوا ذلك لاحقاً، وفي مكان غير هذا. العالم كلّه»، على حد تعبير زاهي خميس). سنأكل - نحن الأمريكان المبجلون بالـ PC -- الأسماك في أي مكان آخر، ولكن ليس في مطعم الـ “aquarium”. أما الأطفال فيمكن لهم أن يأكلوا بعض السمك هنا في مطعم الـ “aquarium” لأنهم لم يبلغوا سن الـ PC، سن الرياء، والنفاق، والكيل بمكيالين بعد.
عصراً تمشينا في المنطقة حيث كان الهواء نقياً ومنعشاً ما كان له أعظم الأثر في استطيابي لنهكة السيجارات المتلاحقة على الرغم من رجاءات [...] بضرورة التخفيف من التدخين احتراماً لهذا الجو المنعش في الأقل. استقللنا قارباً أخذنا إلى «كوين ميري»، «الملكة ميري»، السفينة الرمز الإمبراطوري البريطاني العتيد، التي أصبحت متحفاً عائماً. يذهلني الإنجليز دوماً؛ فهم لا يعترفون على الإطلاق بغروب شمس «الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس»، بل انهم يُعَوِّمونها (حرفيَّا) على طريقة ما يحدث للعملات المأزومة. ها هم الإنجليز قُدَّامي مرة أخرى ومباشرة في البحر، هنا في «لونج بيتش»، في الولايات المتحدة الأمريكية شخصياً. أما ما فعله الإنجليز بالأرض من الجو فذاكرة جبال ظفار والجبل الأخضر أفضل من ذاكرتي بكثير.
أدلفُ إلى «كوين ميري» وأتذكر «تايتنك» المنبطحة حطاماً في قعر المحيط الأطلسي. وأقرأ في المطويَّة السياحيَّة تاريخ محاولات شراء سفينة الركاب الفارهة هذه، وأتامل بيني وبين نفسي فقط هذه المفارقة: ها هم «الإمبرياليون» (الأمريكان) يبتاعون إرث «الكولونياليين» (الإنجليز)، فوالله لقد خربت خيبر فعلاً. وأتأمل أيضاً: تُرى لو كان معنا أحد من أهلي في المصنعة والسويق الضامرين الجوعى الذين رفضوا دفع الضرائب التي كان من المفروض أن تخدم الأحلام التوسعية للإمبراطورية أكثر فأكثر؛ فدكتهم بوارج الإنجليز دكَّاً في عشرينات القرن الماضي حتى اضطروا للانسحاب إلى الجبل لفرط ضراوة القصف البحري الذي استمر ليل نهار فتكاً بهم.. ترى، لو كان معنا أحد أولئك، ماذا سيقول؟. لقد اعترف حتى مؤرخهم العتيد جون بي كِلي متلذذاً بتفاصيل ما حدث في كتابه المرجعي «بريطانيا والخليج». والله، وبالله، وتالله لو كان بيدي لأغرقت «كوين ميري» بصفعة واحدة من غضبي انتقاماً لقطرة دم واحدة فقط من دماء أهلي في السويق والمصنعة.
بالنسبة لي، ولذكرياتي، لم تكن «كوين ميري» سفينة، ولا متحفاً، بل كانت أكبر من ذلك بكثير: لقد كانت وجعاً للذاكرة. طلبت من [...] أن تتركني لوحدي وأنا أتجول في المكان، فقد كان الحِمل أكبر من أن ألقيه على كاهل أحد غيري بمن في ذلك [...] نفسها. كنت مثل الممسوس وأنا أتمشى وأدلف إلى حانات وغرف المجد الامبراطوري الجاثم كسيحاً مهيضاً على الماء.
قبل سنوات بعيدة حلمت بإلحاح أن أجوب العالم كله على ظهر سفينة. كان إعجابي الكبير بروايات حنَّا مينه «البحرية» محرِّكاً لذلك الحلم الذي ضربت أنساغه في ترعرعي في الجانب البحري من مجز الصغرى، ومحاولتي الساذجة الأولى للهرب من خناق الأب وجبروته على ظهر جذع شجرة حفرتُه بسريِّة واتقان لا بأس به - استعانة بكتاب أطفال مٌصَوَّر عن الإنسان البدائي-- على شكل قارب. لكن ذلك الحلم لم يتحقق، ولن يتحقق أبداً.
عدنا ليلاً إلى أسوأ مدينة في العالم، لوس أنجلوس، واستجابة لاقتراحي الشامت والمنتقم من الـ“aquarium” الذي لا يقدم أسماكاً مشوية، فقد دعوت رفاق الرحلة إلى مطعم مأكولات بحرية فاخر في منطقة «المارينا» مع الكثير من القناني السعيدة، و« للبحر وحده سنقول/ كم كنا غرباء عن أعياد المدينة» (سان جون بيرس).
الإثنين 30 يوليو 2001، لوس أنجلوس، كاليفورنيا:
سهر معنا بشير بالحد الذي سمحت به طاقته قبل أن ينام على «الفوتون» في الصالة استعداداً للسفر غداً إلى الجزائر حيث تقلع طائرته في السابعة وخمس وعشرين دقيقة صباحاً. تحسنت حالته النفسية قليلاً (قليلاً جداً فقط) في اثر الوفاة الصاعقة لأخيه الذي أصيب بسرطان لم يمهله طويلاً ــ أقل من أسبوعين بين التشخيص والوفاة. كان يتمنى أن يصل إلى هناك قبل رحيله كي يتسنى له أن يودعه، وأن يرافقه إلى رقدته الأخيرة ولكن ذلك لم يتسنَّ له. ها هو العزيز بشير يعاني من فقد أخ جديد بعد فقد أخيه الذي سقط شهيداً في إحدى المعارك البطولية لجبهة التحرير الوطني الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، والتي - أي المعركة - دارت للسيطرة على كهف كبير فيه ثوار وعتاد ضخم وذخيرة، حيث حكى لي بشير تفاصيل ما حدث.
لقد حررت ثورة المليون شهيد الجزائر، لكن الجزائر لم تُحَرِّر الجزائريين.
