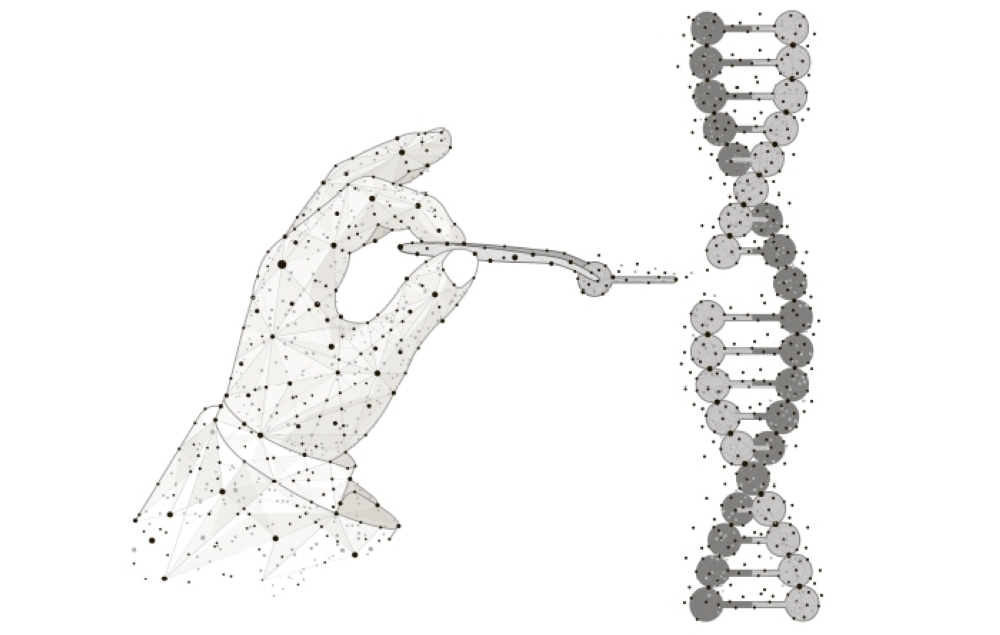قراءة وكتابة الجينوم
22 أكتوبر 2025
22 أكتوبر 2025
بيشوي قليني -
في تاريخ الفكر الإنساني، لا تتولد الأفكار الكبرى في لحظة عبقرية مفاجئة، بل تنبثق من سياق مادي طويل من التجربة، والعمل، وتطور أدوات المعرفة. ما نسميه «اكتشافًا علميًا» ليس قفزة خارقة من عقل فرد، بل هو لحظة اكتمال لمسار تاريخي كانت جذوره ممتدة في الحقول والمختبرات والورش، في تفاعل الإنسان المستمر مع الطبيعة.
لكن، ماذا يعني «الاكتشاف» في زمنٍ لم يعد فيه الإنسان وحده من ينتج المعرفة بل أصبح فيه الذكاء الاصطناعي قادرًا على تصميم التجارب العلمية، والتنبؤ بالنتائج، وابتكار فرضيات جديدة؟ هل ما زال لمفهوم الاكتشاف العلمي - كما عرفناه عبر قرون - مكان في عصر باتت فيه الطبيعة نفسها تُعاد تنظيمها عبر أدواتها الذكية التي أنتجها الإنسان؟
بهذا السؤال يبدأ المقال. ليس بوصفه تأملًا أخلاقيًا في العلم، بل كقراءة مادية لتاريخ علم الجينات، من ممارسات تحسين النسل إلى أداة كريسبر-GPT، كمثال على مسار طويل من التحول، من مراقبة الحياة إلى كتابتها، ومن اكتشاف قوانينها إلى إعادة صياغتها.
جذور الوراثة قبل مندل، حين كانت التجربة فطرة
قبل أن يصبح علم الوراثة علمًا بالمعنى الحديث، عرف الإنسان أن صفات الكائنات تنتقل عبر الأجيال. لم يكن يمتلك المفهوم أو اللغة العلمية لذلك، لكنه مارس المعرفة عمليًا. فالمزارعون في وادي النيل وبلاد الرافدين اختاروا البذور الأقوى والثمار الأجمل لإعادة زراعتها، والبدو انتقوا أنقى السلالات من الخيول والإبل. كانت هذه التجارب نوعًا من الهندسة الوراثية المبكرة، مبنية على الملاحظة المتكررة لا على الفهم المادي للوراثة.
وفي القرن التاسع عشر، برزت أفكار «تحسين النسل» في أوروبا كتعبير اجتماعي عن تلك الممارسات، لكنها كانت محمّلة أيضًا بنزعات سلطوية وعنصرية، إذ برزت الوراثة حينها بوصفها وسيلة للهيمنة على «جودة البشر»، لا لفهمهم. وهكذا ارتبط علم الوراثة منذ بداياته الأولى بالسلطة كما ارتبط بالمعرفة.
بين مندل والـ DNA
في هذا السياق، جاء الراهب النمساوي جريجور مندل ليمثل نقطة التحول من تلك الملاحظات إلى القانون العلمي. في حديقة ديره الصغيرة، راقب نباتات البازلاء بعين إحصائية. حين اكتشف أن الصفات تنتقل وفق نسب رياضية يمكن التنبؤ بها، وضع بذلك الأساس العلمي الحديث لقوانين الوراثة.
لم تعد الوراثة ضربة حظ، بل عملية يمكن قياسها والتعبير عنها بمعادلات. ومع ذلك، لم يعرف أحد ماهية تلك «الوحدات الوراثية» التي وصفها.
مع مطلع القرن العشرين، بدأ العلماء يربطون بين قوانين مندل ووجود تراكيب داخل الخلية تُعرف بالكروموسومات، لكن الجواب الحاسم جاء عام 1953، عندما أعلن جيمس واتسون وفرانسيس كريك، اعتمادًا على العمل الحاسم للعالِمة روزاليند فرانكلين، اكتشاف البنية الحلزونية المزدوجة للـDNA.
لم يكن هذا مجرد شكل هندسي أنيق، بل اكتشاف لفكرة جديدة تمامًا عن الحياة، أن كل كائن هو نص مكتوب بلغة كيميائية من أربعة حروف — A وT وC وG — وأن هذه اللغة تحمل وصفًا كاملاً لبناء الكائن ووظائفه. وهكذا، أصبح الجسد نظامًا مشفرًا يمكن قراءته، وتحولت الطبيعة إلى مكتبة يمكن فك رموزها.
غير أن هذا الاكتشاف لم يكن مجرد لحظة علمية في مختبر، بل تعبير عن مرحلة تاريخية كاملة من تطور القوى المنتجة والمعرفية. فمنتصف القرن العشرين شهد تحوّل العلم من جهد فردي إلى نمط إنتاج صناعي جماعي، تتداخل فيه الجامعات الكبرى والمختبرات المموّلة والشركات التقنية والدول في منظومة واحدة. لم يكن واتسون وكريك ورفاقهما يعملون في عزلة عبقرية، بل داخل بنية مؤسساتية تعتمد على التقنيات الحديثة، وعلى أدوات وموارد لم تكن لتوجد لولا التراكم الصناعي والعسكري للحرب الباردة. إن اكتشاف البنية اللولبية المزدوجة لم يكن ممكنًا لولا توفر أجهزة الأشعة السينية التي أنتجها تطور الهندسة الميكانيكية، ولا لولا التنظيم الجديد للبحث العلمي الذي حوّل المختبر إلى مصنع للمعرفة، تُوزَّع فيه الأدوار مثلما تُوزع المهام في خط إنتاج.
من القراءة إلى الكتابة
ما إن تعلّم الإنسان قراءة الشفرة حتى أراد أن يكتبها. بدأ مشروع الجينوم البشري في أواخر القرن العشرين كمحاولة كونية لقراءة النص الكامل للجسد الإنساني، حرفًا بحرف، في لحظة كان فيها العلم قد تحوّل إلى مؤسسة ضخمة، تمتزج فيها المعرفة بالتكنولوجيا بالتمويل الصناعي. بعد أكثر من عقد من العمل وتكاليف تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، تمكّن العلماء من رسم الخريطة الأولى للجينوم، لكن هذا الاكتمال العلمي كشف نقصًا فلسفيًا عميقًا، لم تكن المعرفة وحدها كافية، لأن المشروع منذ بدايته لم يكن بحثًا عن الفهم بقدر ما كان بحثًا عن القدرة. كان حلم السيطرة على الشفرة قائمًا قبل أن تُقرأ بالكامل، إذ كان العلم في تلك المرحلة قد صار جزءًا من البنية المادية للرأسمالية المتأخرة، حيث تتحوّل المعرفة إلى إنتاج، والبحث إلى صناعة.
هكذا، لم يكن الانتقال من القراءة إلى الكتابة مجرد خطوة تقنية، بل نتيجة منطقية لمرحلة تاريخية بلغ فيها العلم مستوى من التطور يجعله يسعى لإعادة تنظيم الحياة نفسها. ومع ظهور أدوات التعديل الجيني - من أصابع الزنك إلى تالنز - بدأ الإنسان يختبر للمرة الأولى إمكانية التحرير المباشر للنص الجيني، لا عبر الطبيعة بل ضدها. كانت تلك الأدوات خشنة وباهظة، أشبه بمحاولات الكتابة بإزميل على حجر، حتى جاءت لحظة التحول الكبرى عام 2012، حين طوّرت دودنا وشاربنتييه أداة «كريسبر» المستوحاة من نظام مناعي بكتيري.
عندها أصبح لدى الإنسان محرّر نصوص بيولوجي دقيق، رخيص، وسهل الاستخدام. لم يعد العلم يصف المادة، بل يعيد كتابتها. صار الجسد نفسه نصًا قابلًا للتحرير، والحياة مشروعًا هندسيًا، لكن هذا التحول لا يمكن فهمه إلا ماديًا، فكل أداة علمية هي انعكاس لشروط إنتاجها، وكل قفزة معرفية هي ثمرة لتراكم تكنولوجي واقتصادي سابق.
ومن هذا المنظور، لم يكن كريسبر معجزة بيولوجية بل لحظة في تاريخ طويل من علاقة الإنسان بالقوى المنتجة التي شكّلها بيديه. لقد دخل الإنسان طورًا جديدًا من صراعه مع الطبيعة، لكن الصراع هذه المرة لم يعد خارج الجسد — لم يعد في بناء السدود ولا في استخراج المعادن — بل في إعادة تنظيم البنية الوراثية للحياة ذاتها. وهنا يظهر التناقض الفلسفي للمشروع العلمي الحديث، فبينما يتوهّم الإنسان أنه يحقق السيطرة الكاملة على الطبيعة، فإنه في الحقيقة يعمّق اندماجه فيها، لأن العقل الذي يصنع الأداة هو نفسه نتاج تطور مادي طويل. ما يبدو كسيطرة ليس إلا مرحلة من مراحل وعي المادة بذاتها، لحظة تنعكس فيها الطبيعة عبر العقل الإنساني لتعيد ترتيب نفسها من الداخل، في حركة مستمرة بين الفهم والتحكم، بين المعرفة والعمل، بين المادة والوعي الذي وُلد منها.
تكوّن الجينوم البشري من أكثر من ثلاثة مليارات قاعدة نيتروجينية يجعل من المستحيل على البشر وحدهم الإحاطة بعلاقاته وتشابكاته. لم يعد العقل الفردي قادرًا على قراءة هذا الكم الهائل من البيانات، ولا على تتبّع تلك الشبكة الكثيفة من الطفرات والأنماط والتفاعلات. هنا دخل الذكاء الاصطناعي، أولًا كأداة مساعدة لتنظيم البيانات، ثم تدريجيًا كعنصر موازٍ للفكر العلمي ذاته. أصبحت نماذج التعلم العميق تراقب المليارات من السلاسل الجينية، تستخرج منها أنماطًا تربط بين الطفرات والأمراض، ثم تذهب أبعد من ذلك، لا تكتفي بالتفسير، بل تبدأ في التنبؤ، ثم التصميم، وكأنها تعيد تمثيل حركة الطبيعة في فضاء رقمي.
لقد تغيّر معنى «التجربة» نفسها. فبعد أن كانت فعلا مادّيًا يجري على عين الباحث داخل أنبوب اختبار، أصبحت تجربة رقمية تتم في فضاء محاكاة معقّد، حيث يمكن للآلة أن تجري مئات الآلاف من الاحتمالات في وقت واحد، وتستخلص منها أكثر المسارات دقة وفاعلية. أصبح الذكاء الاصطناعي لا يحاكي العالم الخارجي فحسب، بل يعيد بناءه داخل منظومته الخاصة، في زمن مضغوط لا يعرف البطء البشري ولا خطأ اليد. في هذا التحول، لم تعد حدود الممكن العلمي تُرسم على يد الباحث، بل على يد النموذج القادر على توليد الاحتمالات واستبعادها بسرعة تفوق الخيال.
اليوم، خوارزميات الذكاء الاصطناعي تولّد تسلسلات «دليلية» لكريسبر بدقة تتجاوز قدرات الإنسان، وتقلل الأخطاء الناتجة عن القطع في مواضع غير مقصودة. إنها تتعلم من تجارب سابقة وتعيد توظيف المعرفة البشرية المتراكمة عبر مئات الآلاف من المحاولات. لم يعد العلماء بحاجة إلى سنوات من التجريب اليدوي ليصلوا إلى تصميم جيني دقيق، إذ يمكن للنموذج الحسابي أن يقترحه خلال دقائق، متكئًا على بحرٍ من البيانات لا يمكن لعقلٍ واحدٍ أن يسبح فيه.
لكن اللحظة المفصلية كانت في عام 2024، حين ظهرت الورقة البحثية «CRISPR-GPT، An LLM Agent for Automated Design of Gene-Editing Experiments» من جامعتي ستانفورد وبرنستون. للمرة الأولى، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد محلّل لنتائج العلماء، بل شريك في صياغة الفرضية نفسها. لم نعد أمام خوارزمية تترجم تعليمات، بل أمام نموذج لغوي يفكر بلغة البيولوجيا ذاتها، يربط بين الرمز والكود، بين اللغة والمادة. يستطيع عالم الأحياء أن يكتب ببساطة،
“صمّم لي تجربة لتثبيط جين EGFR في خلايا سرطان الرئة A549.”
فيحوّل النظام هذا النص إلى خطة تجريبية كاملة، تحدد الأدوات، البروتوكولات، ونقاط القطع الجيني بدقة مذهلة، وتنتج نتائج تتفوق أحيانًا على التصاميم البشرية نفسها.
في تلك اللحظة، بدا وكأن العلم دخل طورًا جديدًا من تاريخه، طورًا لا يقوم فيه الذكاء الاصطناعي بدور اليد التي تنفّذ أو العين التي ترصد، بل بالعقل الذي يقترح ويبتكر. لم يعد الذكاء الاصطناعي أداة في يد العالِم، بل أصبح شريكًا في التفكير العلمي ذاته، يُعيد تعريف معنى التجربة بوصفها محاكاة للاحتمال قبل وقوعه.
ما الذي يعنيه أن يصبح تصميم الحياة شأنًا لغويًا محوسبًا؟
إنه ليس مجرد تحوّل في أدوات العلم، بل انعطافة في البنية الفلسفية والاجتماعية التي تنظّم علاقتنا بالمادة. فبينما كان العالم في الماضي يقف خارج الظاهرة ليحللها، محاولًا فهم قوانينها من مسافة آمنة، أصبح الآن جزءًا منها، متداخلًا في نسيجها المادي ومندمجًا في بنيتها الإنتاجية؛ فالعقل البشري الذي وُلد من تطور المادة نفسها، أنتج عقلًا اصطناعيًا يعيد تنظيم المادة العضوية التي منها نشأ. غير أن هذه الحركة الجدلية الباهرة، التي تبدو من بعيد وكأنها اكتمال لوعي المادة بذاتها، تنطوي في داخلها على تناقض اجتماعي عميق، فالمادة لا تفكر هنا في فراغ، بل عبر منظومات اقتصادية محددة، تحت سلطة مؤسسات وشركات ودول، هي التي تمتلك أدوات التفكير الجديدة، وتتحكم في اتجاهه وغايته.
إن الذكاء الاصطناعي في مختبرات الجينوم ليس «عقل الطبيعة وقد وعى ذاته»، كما قد يوحي الخطاب العلمي الطوباوي، بل هو أيضًا عقل السوق وقد تجسّد داخل العلم. فالمختبر اليوم هو امتداد لمصنع الغد، والعالم الحديث لم يعد باحثًا عن الحقيقة الخالصة بقدر ما هو موظّف في اقتصاد ضخم يحوّل الحياة إلى بيانات، والبيانات إلى سلعة، والسلعة إلى سلطة. بهذا المعنى، فإن التحوّل الفلسفي الذي جعل العقل والمادة وجهين لعملة واحدة، أنتج في الآن ذاته انقسامًا جديدًا بين من يملكون القدرة على «إعادة كتابة» الحياة، ومن لا يملكون سوى أن تُكتب حياتهم بيد غيرهم. العدالة هنا لم تعد مسألة أخلاقية أو إنسانية مجردة، بل أصبحت جزءًا من البنية المادية للعلم نفسه، من يتحكم في الخوارزميات، يتحكم في الطبيعة التي تُعاد برمجتها من خلالها.
لقد دخلنا زمنًا تتشابك فيه البيولوجيا مع الاقتصاد كما تشابكت من قبل الفيزياء مع الصناعة. فالجين لم يعد رمزًا للحياة فحسب، بل أصبح رأس مال ورخصة ملكية وحقًّا حصريًا في المستقبل. حين تصبح الشفرة الوراثية مجالًا للملكية الخاصة، فإن مفهوم «المساواة» ذاته يفقد معناه الأصلي، فليس الجميع يمتلك الجسد بالطريقة نفسها، لأن الوصول إلى أدوات العلاج والتحسين أصبح امتيازًا طبقيًا جديدًا. في هذا الأفق، تتحول العدالة إلى قضية مادية ملموسة، لا في توزيع الثروة فحسب، بل في توزيع المعرفة والقدرة على إعادة إنتاج الحياة ذاتها.
ولذلك، فإن ما يبدو من بعيد حركة فلسفية داخل المادة، هو في الجوهر صراع اجتماعي داخل الوعي المادي نفسه، فبينما تتعمّق قدرة الإنسان على التحكم، تتعمّق أيضًا الفوارق فيمن يمتلك تلك القدرة. وحين تصبح أدوات العلم امتدادًا لأدوات السوق، يغدو من المستحيل الحديث عن «وعي المادة بذاتها» دون الحديث عن من يمثل هذا الوعي، ومن يُستبعَد منه. فالمعرفة التي تكتب الجسد هي نفسها التي ترسم الحدود بين الأجساد؛ والذكاء الاصطناعي الذي يعيد تنظيم الطبيعة هو نفسه الذي يُعاد تنظيمه بيد من يملكونه. إننا إذن أمام لحظة فلسفية مزدوجة، لحظة ارتقاء في وعي المادة، ولحظة احتدام في اللامساواة داخل بنيتها الاجتماعية.
وهكذا، فإن مسألة «وعي المادة بذاتها» لا يمكن فصلها عن سؤال العدالة، لأن الوعي، في النهاية، لا يتحقق في المختبر وحده، بل في المجتمع الذي ينتج المختبر ويموّله ويحدد غاياته. لقد وصلت المادة إلى طور التفكير في ذاتها عبر أدواتها، لكن ما لم يترافق هذا الوعي مع وعيٍ اجتماعيٍ بتوزيع تلك الأدوات، سيبقى التفكير ناقصًا، لأن جزءًا من المادة — أي جزءًا من البشرية — سيظل يُستبعَد من حقه في المشاركة في كتابة تاريخه البيولوجي والمعرفي. هنا يتضح أن المسألة لم تعد فقط «فلسفية» حول علاقة الإنسان بالطبيعة، بل «مادية» حول من يملك حقّ التفكير باسمها وإعادة تشكيلها.
بيشوي قليني كاتب ومهندس بيانات