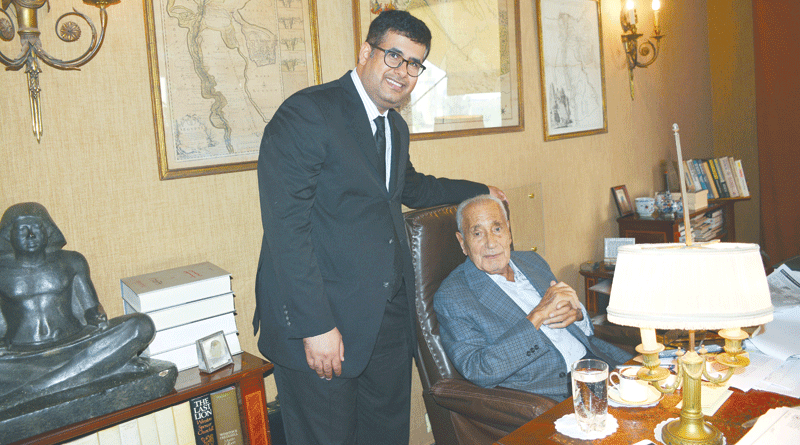
يوميات في القاهرة: عن أماكن نجيب محفوظ والبحث عن هيكل وانطفاء ميدان التحرير
عاصم الشيدي -
«1»
عــلى ضفاف النيــــل
عندما زرت القاهرة أول مرة صيف 2001 لم يكن ميدان التحرير يعني لي شيئا، وربما مررت به كثيرا دون حتى أن أعرف اسمه. لا بد أنني مررت به وأنا ذاهب إلى وسط البلد قادما من الدقي، أو وأنا أبحث عن مكتبة مدبولي ومكتبة الشروق وسور الأزبكية. لم يكن ميدان التحرير في ذلك الوقت يحمل أي رمزية بالنسبة لي على الأقل. كانت أماكن نجيب محفوظ هي الأهم: الحسين وخان الخليلي والسكرية وقصر الشوق وبين القصرين، وزقاق المدق، حي الجمالية، كنت مهووسا بهذه الأماكن الروائية الأثيرة وبالمقاهي التي كان يجلس فيها محفوظ وحرافيشه، أو بالبحث عن بعض أبطاله على اعتبار أنه كان ينقل أجواء رواياته من بعض تفاصيل حياته اليومية.. ولذلك بحثت عن مقهى الفيشاوي ومقهى ريش وفي الفيشاوي سألت عنه لكن كان قد ترك هذا المقهى وغيره لسوء حالته الصحية وتقدمه في العمر. أحد أصدقاء تلك الرحلة عبد العزيز الغافري كان يكرر في كل حين «هلكتنا بنجيب محفوظ هذا» لكنه تكرم وذهب معي إلى الحسين بحثا عن محفوظ وبحثا عن أماكنه، وتكرم وذهب معي مرة أخرى إلى مدينة نصر بحثا عن معرض الكتاب قبل أن نكتشف أن سائق التاكسي قد نصب علينا، فلم يكن الوقت وقت معرض الكتاب، رغم تأكيده أنه يوصل الكثير من الزبائن يوميا للمعرض في مدينة نصر. أذكر أنه طلب مبلغ 50 جنيها عن تلك التوصيلة، وكان مبلغا محترما في ذلك الوقت. لم أكن حينها مشغولا بعدُ بالصحفي الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل ولذلك لم أكن أفكر في لقاء به ولو على سبيل الصدفة. سكنت في ميدان فيني بالدقي في فندق يحمل اسم «إنديانا» وأقدر الآن إنه على مرمى حجر من العمارة التي بها شقة الأستاذ هيكل، وربما صادفته وأنا أسير في الصباح الباكر أو في المساء لكن لم أكن لأعرفه ولم يكن ضمن اهتماماتي أبدا في ذلك الوقت. كنت أسير من الفندق باتجاه شارع النيل ثم من شارع النيل باتجاه كوبري 6 أكتوبر، وشقة الأستاذ هيكل تقع في 92 شارع النيل ـ العجوزة ـ الجيزة بالطابق الخامس بجانب فندق شيراتون القاهرة. عندما أتخيل المكان الآن أستطيع الجزم أنني سرت كثيرا من تحت تلك العمارة. وأنني سكنت في مرات لاحقة في فنادق قريبة جدا منها وتريضت أمامها أنا وأصدقاء كثر في زيارات لاحقة، لا بدّ أنني رأيته في الشارع صدفة دون أن أعرفه. صحيح أن القاهرة بها أكثر من 10 ملايين شخص لكن هيكل كان هرما بارزا بها وكان يمكن بسهولة رؤيته لمن يبحث عنه بمعرفة.
جرت مياه كثيرة تحت نهر النيل بين عام 2001 وبين 2011 وأصبح ميدان التحرير أحد أشهر الميادين في العالم، وصار قبلة السياح والسياسيين والصحفيين والحقوقيين في العالم. وأذكر أنه لم يمض شهر واحد على أحدث فبراير 2011 في مصر حتى قامت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بزيارة الميدان والتصوير فيه، وفورا تناقلت صورها وكالات الأنباء العالمية. وفي عام 2013 عندما ذهبت للقاهرة على أمل أن ألتقي بالأستاذ هيكل الذي أصبح حينها مثلا أعلى بالنسبة لي، وحلما من أحلامي، وشاغلا من أكبر شواغلي، لم أستطع الانتظار حتى اليوم التالي رغم وصولي الفندق مساء. وضعت حقيبتي في الفندق ومنه مباشرة إلى ميدان التحرير. كانت هذه أول زيارة لي للقاهرة بعد أحداث الميدان. كانت مصر حينها قد بدأت تضيق بحكم محمد مرسي رغم أنه لم يكمل عاما بعد، وكانت الشوارع مليئة بالاحتجاجات والعين على ميدان التحرير الذي لم يكن قد فقد بريقه أبدا. ولم يمض وقت طويل من ذلك اليوم حتى عاد الميدان للواجهة مرة أخرى وفي يونيو 2013 انقلب الميدان على مرسي ضمن أحداث دراماتيكية لا تحدث إلا في العالم العربي. في تلك الزيارة لم أظفر بلقاء الأستاذ وانتهى الأمر بمحادثة هاتفية اعتذر فيها عن اللقاء نظرا لكونه خارج القاهرة ويعود لها بعد أربعة أيام و»قد» نلتقي لو بقيت في القاهرة حتى ذلك الوقت. اعتذرت منه لأنني عائد لمسقط بعد يومين ومن مسقط في مهمة عمل إلى باريس. لا أعرف الآن كيف فعلت ذلك بالضبط، ولمَ لم أتمسك ببصيص الأمل في اللقاء، ولكن «قد» تلك أقلقتني كثيرا لأنها لم تحمل لي أملا مؤكدا بلقاء ولو كان عابرا.
وفي سبتمبر 2015 عدت للقاهرة مرة أخرى، وكان قد تأكد أنني سألتقي بالأستاذ هيكل هذه المرة في مكتبه بعد لقاء الصدفة في نوفمبر 2014 في مدينة باريس وتلك مصادفة ساقتها لي الأقدار. كان ميدان التحرير قد فقد الكثير من بريقه ولم يعد ذلك المزار الذي يحرص عليه السياح. ولذلك عندما مرّ عليّ الصديق يوسف القعيد في فندق جراند حياة ليأخذني بالتاكسي لمقابلة الأستاذ هيكل صباح يوم السبت 11 سبتمبر لم ألتفت لميدان التحرير والسيارة تنعطف يسارا فوق كبري 6 أكتوبر. ليس لأن المقابلة/ الحلم كانت قاب قوسين أو أدنى من التحقق فقط وكانت تشغلني عما عداها ولكن لأن وهج الميدان قد خبأ، وإلا كان يمكن أن يكون الميدان، الذي تتضح معالمه من شرفة مكتب الأستاذ، مدخلا لحديث عن القاهرة وأحوالها والمتغيرات التي تحدث فيها كل يوم، رغم ذلك كان مفتتح الحديث مع الأستاذ عن الطريقة التي تم بها القبض على وزير الزراعة في ذلك الوقت صلاح هلال، المتهم بالفساد، والذي ألقي القبض عليه في الميدان نفسه وبطريقة بدت أنها غير مقبولة أو مستساغة، وقال الأستاذ إنه اتصل بالرئيس وأبلغه موقفه من الطريقة التي تم بها القبض على الوزير، معتبرا أنها أقرب لطريقة المافيا منها إلى طريقة الدول. ربما حدثت تلك الجفوة مع الميدان لكثرة قراءة ما كان يكتب عنه باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية والذي كان الصديق أحمد شافعي يتكرم مشكورا ويترجمه للنشر في جريدة عمان طوال سنوات وهج الميدان وحضوره الإعلامي.
وبعد أربع سنوات وفي مطلع شهر سبتمبر الماضي من هذا العام 2019 عدت للقاهرة مرة أخرى بعد شوق طويل لزيارتها. لم أكن مهتما كثيرا بميدان التحرير لا في الصباح الباكر ولا والشمس تنحدر باتجاه ■ الغروب وفق السياقات الرومانسية لعشاق الأماكن الأثيرة، كان ميدان التحرير بالنسبة لي مثله مثل أي ميدان آخر، صحيح أنني سرت فيه أكثر من مرة ولكن كان الأمر عاديا جدا، لا يكشف لا عن دهشة ولا عن إعجاب ولكن أيضا لا عن قطيعة بسبب مآلات ما بعد 2011 عربيا، رغم أن الصدف لعبت دورا غريبا، فبعد عودتي من القاهرة بدا أن ميدان التحرير يمكن أن يعود للواجهة مرة أخرى، حيث نقلت وكالات الأنباء والفضائيات عمّا يمكن أن يكون إرهاصات حراك شعبي في مصر، إلا أنه سرعان ما انطفأ وعادت الأمور إلى رتابتها والميدان إلى انطفائه.
سكنت في فندق بالزمالك وكان أول مشوار مسائي لي في هذه المدينة زيارة الحسين مع مجموعة الأصدقاء. في الطريق رأيت أضواء مكتب الأستاذ هيكل مطفأة، كان المشهد مؤلما جدا بالنسبة لي، وفي الحقيقة كان قلبي يعصرني من اليوم الذي قررت فيه السفر لمصر وكنت أعرف يقينا أن لا أمل لي على الإطلاق هذه المرة في رؤية الأستاذ هيكل ولا في مرات أخرى مهما عدت للقاهرة ومهما تريضت في شارع النيل أمام العمارة التي فيها شقته ومكتبه. على الأقل في المرات السابقة كنت أمني النفس أن ألتقيه، أو أن يرتب لي القدر صدفة رؤيته كما حدث في باريس. كان ذلك في نوفمبر من عام 2014، كنت أسكن في فندق صغير خلف شارع الشانزليزيه، وفي المساء قرأت خبرا في صحيفة مصرية أن الأستاذ يزور أكثر من دولة أوروبية بدأها بلندن وبعد لندن سيكون في باريس. تمنيت أن يكون الآن قد وصل باريس وأن يكون مقيما في فندقه الأثير: كيرون الذي يحتضن ميدان الكونكورد ويقابل المسلة المصرية التي تقف شامخة فيه، وهو الفندق الذي اعتاد الأستاذ الإقامة فيه منذ منتصف القرن الماضي. قلت في نفسي لا بد من الذهاب لهذا الفندق في الصباح وتناول فنجان قهوة علّ القدر يرتب لي الموعد المنتظر. المفاجأة غير السارة كانت عندما اكتشفت بعد جولة بحث في الانترنت أن الفندق مغلق لمدة عام للصيانة بعد أن اشتراه مستثمر خليجي. لكن القدر كان كريما معي أكثر مما أتوقع، فبينما كنت أسير ومجموعة من الأصدقاء في شارع الشانزليزيه إذا بالأستاذ هيكل يمر إلى جواري، لوهلة اعتقدت أن الأمر لا يعدو كونه خيالا لكثرة التفكير في مثل هذه الصدفة أو أنني أتوهم الشبه، وللإمساك بحقيقة اللحظة قلت في ذهول: الأستاذ هيكل! التفتَ، وكان بصحبته وزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة، وقال وهو يبتسم «أهلا وسهلا يا فندم»، كان هو، هو، شعرت وكأن الدنيا لا تسعني أبدا. أي قدر هذا الذي ساقني إلى هنا في هذه اللحظة من هذا الصباح الخريفي الذي تسطع شمس وتنير سماء مدينة الجمال والأحلام باريس. كان ذلك اليوم من الأيام التي لا يمكن أن أنساها أبدا، ولا أستطيع ذلك. دارت أحاديث مقتضبة بيننا غلبت عليها الفرحة والبهجة، لاحظ الأستاذ هيكل أننا نتجاهل بشكل كبير غسان سلامة فتبرع بتعريفنا أنا وأصدقائي به. قلت له إنني أنتظر وعده بالحوار، وإنني سأكون سعيدا لو تحقق الوعد هنا في باريس. لكنه اعتذر! وقال إن جدوله مزدحم جدا خلال أيام وجوده هنا. ورغم الفرحة الكبيرة ذلك اليوم إلا أنني اعتقدت لاحقا أنني تصرفت بشكل غير موفق. ما كان يمكن أن أحدثه عن الحوار في لقاء عابر جمعنا على «الرصيف» كما وصفه لاحقا عندما دخلت مكتبه ورآني «أنا شفتك على الرصيف في الشانزليزيه قبل كدا؟». يا لذاكرته الحديدية التي لا تنسى أدق التفاصيل. ولثلاثة أيام لاحقة كنت أتسكع على أرصفة ومقاهي باريس على أمل أن تتكرر الصدفة الجميلة مرة أخرى. ولكن مثل هذه الصدف لا تتكرر إطلاقا.
«2»
مقهى الفيشاوي
2 سبتمبر 2019
شعرت بألم كبير عندما أقدم نادل مقهى الفيشاوي، الذي انتهت جولتنا في الحسين إليه، على ضرب طفلة صغيرة تبيع ورق المحارم أرادت أن تداعبني بطريقة تجبرني بها على شراء المحارم منها. لم أكن منزعجا منها رغم أن كثرة المتسولين في الحسين مزعجة جدا جدا.. كانت الطفلة خفيفة الظل، وتحمل الكثير من روح المصريين الحقيقية، رغم طفولتها البائسة أو المنزوعة منها قسرا.. شعرت أنني تسببت لها بذلك الضرب القاسي الذي لا يليق بعمرها وطفولتها أبدا.
يكثر المتسولون الأطفال في الحسين لأن المافيا التي تديرهم تعرف يقينا أن أغلب زوار الحسين من السياح الأجانب وأنهم في الغالب يستطيعون الدفع أو أن كثرة مضايقتهم تجعلهم يدفعون دفعا للبلاء أكثر منه طلبا لأجر الصدقة. استعدت مع الأصدقاء ذكريات مقهى الفيشاوي عندما أتيته في عام 2001، لا أذكر التفاصيل كثيرا ولكن أذكر اللهفة، وأنا لدي وفاء كبير للأماكن وذكرياتها.
استمرت سهرتنا في الفيشاوي إلى ما يقرب منتصف الليل ولكن كنت أفكر في الطفلة التي صُفعت على وجهها بسببي وطردت خارج المقهى.. مئات الأطفال هنا أجبرتهم الظروف وربما عصابات مافيا الأطفال على احتراف التسول، وعلى ترك طفولتهم جانبا، إن كانوا شعروا بها يوما في الأساس، واحترفوا مهنة لا يعود «خيرها» عليهم ولكن على العصابات التي تأويهم في ظروف لا إنسانية ولا نصيب لهم منها إلا كسرة خبز يابسة إن وجدت وثياب رثة. وتنبهت السينما المصرية لهذه المشكلة منذ وقت مبكر ومنذ منتصف أربعينات القرن الماضي حينما قدم يوسف جوهر فيلم «الأبرياء»، ثم تلاحقت أفلام غيره مثل «أولاد الشوارع» و»جعلوني مجرما» و»العفاريت» وغيرها الكثير، ويندر أن يخلو فيلم مصري من مشاهد التسول. فكرت كيف يرانا هؤلاء الأطفال خارج سياق أننا «جنيها» يمكن أن يمتد لهم. كيف ينظرون لنا ونحن نجلس على هذه الأرائك الوثيرة نحتسي فناجين الشاي والقهوة ونضحك ونستعيد ذكرياتنا فيما تنكسر أمنياتهم عند حدود التفكير بغير مد اليد أو عرض علبة محارم صغيرة كوسيلة مطورة للتسول أو تجنبا لكلمة مؤذية هي التسول واستبدالها بكلمة ألطف هي «بيع».
لا تعرف الطفلة التي صُفعت على وجهها ربما مئات المرات في هذا المكان ماذا تعني طفولة؟ وماذا تعني أسرة؟ وماذا تعني البهجة، أو حتى ماذا تعني فكرة الجلوس في مثل هذه المقاهي والتأمل في وجوه المارة. لأنها لم تكن يوما في وضع المتأمِل ولكن المتأمَل
شعرت بظلم العالم أجمع ينثال في تلك اللحظة فيعيد صفع الطفلة الصغيرة مئات المرات.
كنت في عالم آخر فيما كان الأصدقاء يتحدثون ويضحكون ويقرأون رسائل الواتس أب بعد أن طارت صورنا عبر فضائه لعُمان. راقبت الوجوه التي تمر هنا وهناك، رأيت امرأة عجوزا متسولة أعاقت حركة متسولة أخرى أكبر منها سنا كانت تتكئ على عكاز ضخم.. نظرتْ لها نظرة حقد وقالت لها «يا ختي..» ما تخلصي مال».
لم يكن عبده أحد نُدُل مقهى الفيشاوي ينادي الطفل الذي يحمل أكثر من 25 كتابا ويدور بها وسط مقاهي الحسين باسمه رغم أنه يعرفه تماما، ولكن كان يناديه بعبارة «عدي يا كُتب».. ومثل هذه العبارات مشهورة في القاهرة، فصاحب سيارة الأجرة تتم مناداته «يا أجرة» وقد سمعت شابا ينادي صاحب التاكسي الذي كنت فيه بعد أن تأخر في دخل الشارع « أيه يا أجرة!»، حضر صاحب الكتب هذا خلال سهرتنا أكثر من عشرين مرة وهو يحمل نفس الكتب دون أن يشتري منه أحد ولو كاتبا واحدا، أما الفتاة الثلاثينية التي حولها الفقر إلى عجوز شمطاء فجاءت ورمت على طاولتنا بعضا من الفول السوداني على أمل أن نأكله ثم تبدأ عملية الحساب بعد ذلك، بعد نصف ساعة عادت لتجمع ما رمته وتبدأ عملية الجدال حول السعر.
كان عليّ أن أبحث عن تلك الطفلة لأشتري منها المحارم علّ ندمي يقل جراء الصفعة التي نالتها بسببي! بحثت عنها وسط الزحام، ووسط الغرباء الذين يكشفون عن أنفسهم بسهولة في الحسين لأنهم مقصد المتسولين.. وفيما كنت أودع المكان أمام المسجد مباشرة لاحظت مئات الأطفال والنساء يتجمعون هنا. هم نفسهم الذين كانوا يمرون وسط المقهى، وسط مقهى الفيشاوي وأمام مطعم نجيب محفوظ، والعجائز اللاتي تشاجرنا أمامي، والمرأة التي رمت على طاولتنا الفول السوداني.. بحثت عن الطفلة، تأملت وجوه العشرات والعشرات من الأطفال. عدت للصور في هاتفي للتأكد من شكلها ثم عدت أبحث.. ثم رأيتها، رغم كل التعب الذي مر عليها في هذا اليوم، ورغم الخذلان، ورغم الصفعة التي تلقتها، ورغم ما يمكن أن ينتظرها في ليلة أخرى من ليالي مافيا التسول إلا أنها كانت تبتسم، وتضحك، ناديتها لأعتذر لها، لأعتذر لإنسانيتها، لطفولتها التي لا تعرفها وللمصطلح الذي لم تسمع به ربما، لأعتذر لابتسامتها التي أخجلتنا. وقبل أن تغادر إلى وسط مئات الأطفال سألتها عن اسمها وقالت «رحمة».
