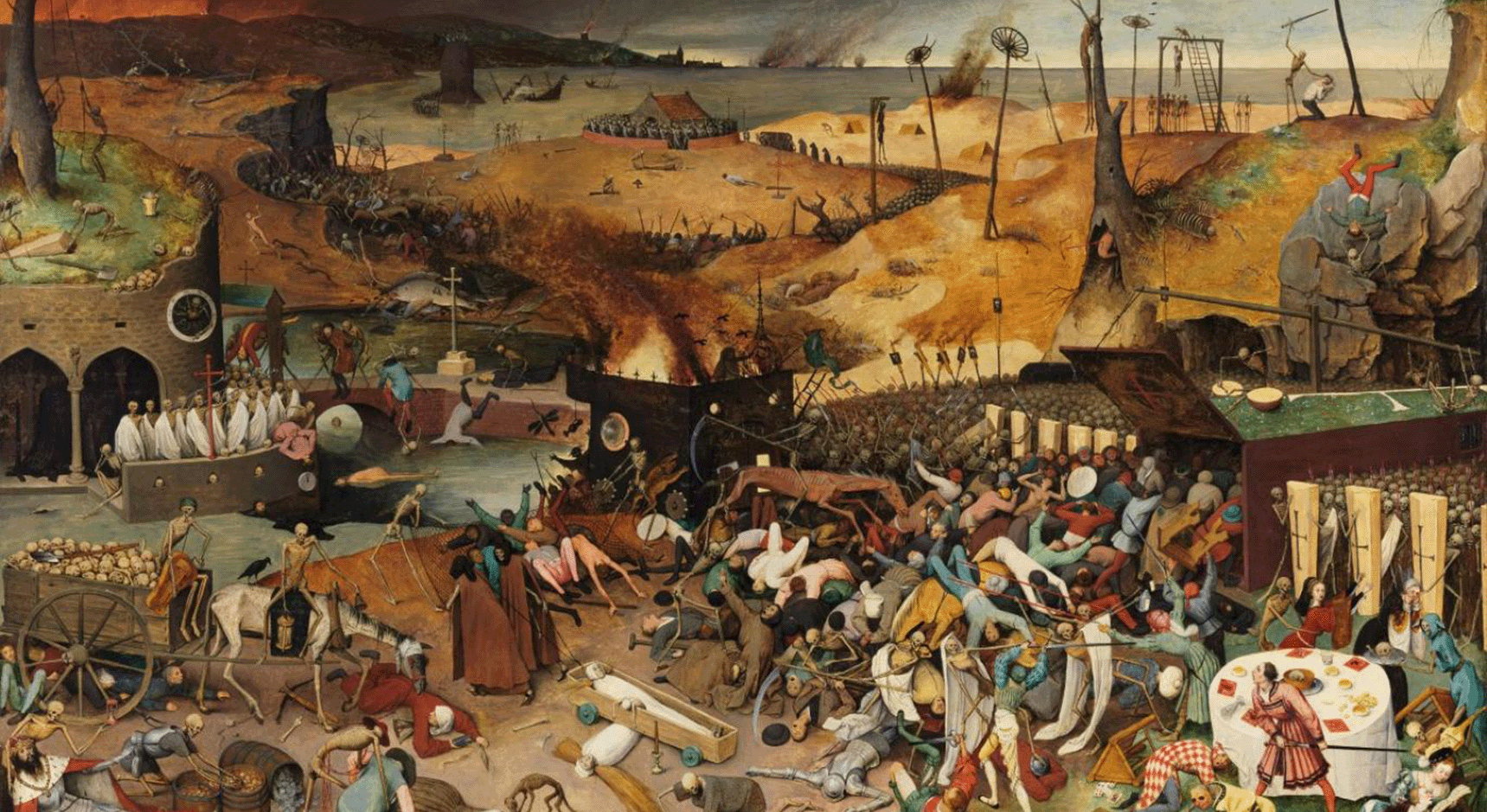
يوميات صحفي يتابع أخبار كورونا

عاصم الشيدي
لم أعد أحتاج إلى منبه للاستيقاظ صباحا، كوابيس الموت الليلية وروائحه تكفلت بالأمر على أكمل وجه. عند الثامنة أكون قد كنست ما بقي من تلك الكوابيس بماء وصابون على أمل ألّا يبقى من فيروساتها شيء عالق للنهار. والماء والصابون صار هوسا يوميا في حياتنا منذ ظهور فيروس كورونا، رغم طول البقاء في البيت، ولكن ما يدرينا أين يخاتلنا هذا الفيروس اللعين الذي قلب موازين العالم رأسا على عقب، أو أين يستقر على هذه الأسطح التي تُمسح بالديتول طوال الأسبوع قبل أن تُمسح بخطواتنا ونحن ندور في نفس الحلقة يوميا في انتظار فرج السماء.
هذا هو الأسبوع الثاني لي منذ أن بدأت أباشر عملي من البيت، بعد أن أعفت الدولة الموظفين من ضرورة الحضور إلى مقرات أعمالهم إلا للضرورة القصوى حين لا تستطيع التقنية الحديثة إيجاد البديل المتوفر. لم أحتج للذهاب للجريدة إلا نادرا، رغم أنها على مرمى ربع ساعة بالسيارة مني، ومكنتني التقنية من مراجعة مواضيع الجريدة من البيت، ومتابعة إخراجها، أما اجتماعات التحرير اليومية فتكفلت مجموعة على برنامج "واتس أب" بها، وهذه المجموعة جعلت اجتماع التحرير قائما طوال اليوم. لم يدر في خلد أي مدير تحرير قبل سنوات أنه يمكن أن يعمل بدون "صالة تحرير" وبدون أن يقابل المحررين يوميا ويدخل معهم في نقاشات لا تنتهي. لكن هذا يحدث الآن، نعمل في وسط أزمة طارئة، لكنّها تجبرنا، بحكم المنطق، وبحكم القانون أيضا، ألا نلتقي على الطبيعة ونعمل عن بُعد. رغم ذلك يُبلي الزملاء بلاء حسنا مع كل الظروف في مسقط التي تحولت إلى بؤرة مركزية للوباء في السلطنة، ورغم أن ساحة المعركة الحقيقية في غرف العناية المركزة في المستشفيات، وهي منطقة خطرة، والاقتراب منها يعني معاودة زيارتها بعد أيام أخرى ولكن كمريض لا كصحفي، إلا أن الزملاء يحاولون الاقتراب بالقدر الذي لا يسبب "الاحتراق". وهناك فريق آخر من الزملاء لم تسعفهم التقنية على البقاء بعيدًا عن صالة التحرير، وآخرون في الميدان يخاتلون المشهد لتوثيقه بالكلمة والصورة.
لسنوات كنت أعتقد أن العمل من البيت مكسب كبير لأي صحفي مثلي يريد الالتفات لحياته الأسرية التي سرق الزمن كثيرًا مما تستحقه من وقت واهتمام بسب طبيعة العمل الصحفي التي تقتضي بقاء طويلا خارج البيت وبشكل مستمر. لكن تجربة الأسبوعين لا تنبئ بأكثر من غربة جديدة، أكثر قسوة؛ أن تكون أكثر غيابًا وأنت حاضر في المنزل وسط عائلتك. جعلتني ابنتاي ريم وشهد أذرف دمعًا في غير وقته عندما قرأتُ رسالة كتبتها ريم طالبة الصف السادس باسمها واسم أختها تقول: "بابا خصص لنا نصف ساعة يوميا، فقط، نعيش فيها معك حياة عائلية نلعب ونضحك مع بعض، بعيدا عن هاتفك أو لابتوبك". لم أملك دمعتي عندما قرأت الرسالة ونظرت في عيون ابنتي لأعرف أنها ليست مجرد رسالة عابرة ولكنها حاجة حقيقية!
أنْ تكون صحفيا يعني أن ترهن كل وقتك لصحيفتك، ولمتابعاتك المستمرة، أن تخرج صباحا من البيت وقد ذهب أطفالك للمدرسة ولا تعود إلا بعد منتصف الليل عندما يكون أطفالك قد خلدوا للنوم. وفي العمل من البيت الآن أنت تقوم بالأمر نفسه. الفرق الوحيد أنك سابقًا غير مرئي أمامهم بعد خروجك من البيت، وفي هذا ما يمكن أن يقنعهم بغيابك، لكنّك الآن مرئي، يراك أطفالك دون أن يستطيعوا الاستمتاع بدفء وجودك. في السابق كنت تحصل على إجازة أسبوعية تعوض فيها بعض الغياب، ولكن في المشهد الجديد فإن ترف الإجازة غير موجود أبدا. ما يزيد المشهد إيلاما لعائلتك أن أكثر الناس الملتزمين بيوتهم هم بلا عمل حقيقي، وفي أصعب الظروف عمل طفيف، وكأنهم يعيشون إجازة سنوية طويلة ولذلك يتحدثون عن برامج وفعاليات وأنشطة يفعلونها في البيوت من أجل تمرير الوقت الذي يسير ببطء شديد. لكن هذا غير متاح للصحفيين لأنهم شركاء في المعركة التي تدور في الخارج. وفي الحقيقة فإن توقف الطبعة الورقية، بحكم القانون أيضا، أضاف أعباء كثيرة على الصحف التي كانت تنتهي دورة عملها بإرسال الصفائح المعدنية إلى المطبعة التي تبدأ عادة في الدوران عند منتصف الليل لكن الآن العمل مستمر طوال اليوم بحكم طبيعة الانتقال من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية.
حاولت أن أشرح لبناتي أننا نعيش حالة طارئة، وأنني موجود في البيت على الأقل، لكنّ هناك أطباء وممرضين موجودون في ساحة المعركة. تسأل ريم: "أين تقع ساحة المعركة؟" أجيب: "تقع في المستشفيات، في غرف الطوارئ وغرف العناية المركزة. وهناك رجال الجيش والشرطة المنتشرون في جميع شوارع عُمان وطرقاتها".
تنظر شهد لي قبل أن تقول: "نزين باكر طلع العب معنا كورة في الحوش". أقول لها: حاضر.
بعد أن كنست آخر صور الموت التي تراءت لي في كوابيس الليل، فكرت أن عليّ التأكد مما إذا كان وزني قد زاد رغم المحاولات المضنية لإنقاصه. العزلة تفرض المزيد من الأكل، ولم أستطع بناء تصور يربط بين كثرة الأكل وعزلة كورونا الجبرية هذه، غير أن وسائل التواصل الاجتماعي قد كرست الفكرة، فهي تعجّ بالكثير من الصور لطبخات جميلة ومغرية تتفنن في إعداداها الأسر؛ في محاولة ربما، لكسر رتابة المشهد وتمرير الوقت الصعب. وعموما هذه من سخرية القدر أن نجابه الخوف من الموت اختناقا بمزيد من الأكل. المؤكد لي الآن أن المطبخ هو أكثر مكان ألتقي فيه بعائلتي. نبتسم لبعضنا البعض ونضحك وكل منا يحمل صحنه ويمضي إذا لم يكن وقت اجتماع على غداء أو عشاء.
أبحث في وكالات الأنباء، التي صرت أستقبلها على حاسوبي الشخصي وأنا أجلس في مكتبي في البيت، عن خبر غير خبر الموت وصراع الطواقم الطبية وغرف العناية المركزة معه فلا أجد. لا أحد يكتب إلا عن الموت، ولا أحد يحصي إلا ضحايا الفيروس؛ فنحن لا نكتب إلا ما يسكننا، وكل من على وجه الأرض اليوم مسكونون بالموت والخوف من مجيئه فجأة في غير أوانه. أكثر من مائة ألف من البشر فاجأهم الموت فيما كانوا يحلمون بسنة مختلفة تنضج فيها الأحلام دون أن تسقط أوراقها على قارعة الوباء.
لم أعش أحداث الحرب العالمية الثانية إلا عبر الكتب والأفلام السينمائية ولكن ما يمر به العالم اليوم هو حرب عالمية ثالثة حقيقية. حرب لها جنودها الذين يعرفون عدوهم دون أن يروه، يحصون قتلاه الذين مكنهم العلم من بناء مؤشر إحصائي لسقوطهم اليومي، لكن نفس ذلك العلم لم يسعفهم حتى الآن في اكتشاف ترياق يوقف هذا الفناء الجماعي للبشرية.
أخبار وكالات الأنباء مفزعة جدا، هذه إحصائية أمامي عن عدد الوفيات في الولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، يا رب السماء! العدد تجاوز ألفي حالة وفاة.. بالمنظور الصحفي الذي عليّ أن أمارسه الآن هذا خبر مهم، ولا بد أن يبث على موقع الجريدة فورا، وعبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن على المستوى الشعوري والإنساني هذا خبر مؤلم جدا، ومخيف. هذا فناء بشري، وانتحار جماعي للجنس البشري. أعد الخبر للنشر فيما تسري رعشة في جسدي وأحاول أن أبحث عن صورة مناسبة له. هل أختار صورة وكالة الأنباء الفرنسية التي تظهر مئات الجثث وقد تناثرت في مستودع لمستشفى في نيويورك؟ إنها صورة مؤلمة ونشرها قد يخدش مشاعر الكثيرين، رغم كونها صورة صحفية تعبر عن حجم المأساة الحقيقي، أم أختار صورة أخرى جاءت عبر وكالة رويترز لمسن وُضع على سرير بعد إنزاله من سيارة الإسعاف وفي طريقه لطوارئ مستشفى في منهاتن الأمريكية وتبدو يده ممدودة بكثير من الرجاء للمسعف وكأنه يقول له: أرجوك لا أريد الموت الآن فلم أودع أحبابي بعد. أم أختار صورة أخرى تخبئ فيها فتاة عشرينية رأسها بين ركبتيها بعد أن يئست من المشهد السريالي وهي تجلس قبالة مستشفى دخل إليه والدها. يعقب هذا إحصائية جديدة من إيطاليا، وأخرى من إسبانيا، ثم إحصائية جماعية للأرواح التي حصدها الوباء في العالم أجمع.
هذه معاناة أخرى.. وكالات الأنباء تنقل لك بالصورة والكلمة كل معاناة العالم، فجائعه وويلاته في هذا المنعطف التاريخي، وأنت عليك أن تعيش كل هذه المآسي قراءة ونظرا، ثم عليك أن تختار!
عند الساعة العاشرة صباح كل يوم تصل الإحصائية المحلية للمصابين بالفيروس في عُمان، وهي وإن كان عددها ما زال محدودًا مقارنة بمؤشرات في العالم ترتفع كل يوم بالآلاف إلا أن دراستها باعتبارها منحنيات رياضية تكشف عن خوف كبير جدا. هذا المنحنى يرتفع كل يوم، ويتضاعف في أيام محدودة جدا رغم كل الجهود التي تبذل، ورغم أن البلد كلها مغلقة تقريبا. ورغم عزل المحافظات عن بعضها البعض.
أستعد لحضور مؤتمر صحفي لوزير الصحة يعقده عبر تطبيق "زوم" العالمي. هذه تجربة جديدة، يتحدث الوزير عن منحنى وبائي أعدته وزارة الصحة يفترض أن نصل مع نهاية شهر إبريل إلى ذروة الوباء في السلطنة، وعند تلك النقطة يمكن أن نسجل كل يوم 64 وفاة، يصعقني الرقم فهذا رقم لا نستطيع تحمله في شهر في عمان فكيف في يوم واحد، يقول الوزير: "لا بد أن نتحدث بشفافية، وهذه أرقام ومنحنيات أوجدها علم الرياضيات ولكن نتمنى ألا نصل إليها إذا ما تحقق التباعد الاجتماعي". كيف يمكن أن أنقل هذه المعلومة، أشعر الآن أن يدي ترتجف وأنا أكتب الرقم. رائحة الموت التي تغطي العالم لن تستثنينا، إنها قادمة وعلينا أن نستعد لها.
تصل الأخبار من كل الولايات والمحافظات وتصب أمامي الآن، وعليّ أن أراجعها وأمرر ما يمكن نشره، وأستبعد الأخبار التي لا ترقى للنشر. المهمة الأصعب الآن هي أن أتأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، كل معلومة غير صحيحة يمكن أن تقود إلى كارثة. وفي الأزمات تجد الإشاعة مكانا مثاليا لها.
أعود لاجتماع التحرير الذي لا ينتهي على "واتس أب" أناقش مع الزملاء أفكارا لمواضيع يمكن تنفيذها، بعضها عاجل وبعضها قابل للاشتغال على مهل. لكن الأخبار في بلادنا لا تولد بسهولة حتى في الأزمات، إيقاع ولادتها بطيء جدا. الناس هنا لا يتحدثون كثيرا، والكثير من القصص الصحفية يقتلها التحفظ سواء من الأفراد أو من مؤسساتهم عندما يتحدثون باسمها.
قبيل المغرب تستدرجني ابنتي شهد إلى الخارج لأتفاجأ أن عليّ أن ألعب معها وأخواتها لعبة "عنبر"، أتذكر هذه اللعبة التي كنا نلعبها صباحا قبل أن نركب الباص للمدرسة. وكنت أعتقد أنها انتهت وانقرضت في زمن الأيباد، ولكن يبدو أن العزل المنزلي سيعيد الماضي وإنْ في سياق آخر. يقطع صوت أذان المغرب فسحة شهد التي فرحت بها. أما أنا فأجد عدة أخبار قد تراكمت وعليّ مراجعتها، رغم أن زملاء آخرين ينضمون لمراجعة الأخبار في هذا التوقيت. يستمر المشهد مع أخبار الوباء وضحاياه حتى منتصف الليل. وهو الوقت الذي أعود فيه ثانية لمعركة أخرى مع كوابيس الموت وروائحه التي لا تنتهي حتى أغسلها في الصباح بالماء والصابون. قبل أن أغمض عيني أتذكر شهد وريم وسحر ووسن، أتذكر النصف ساعة فقط التي تحتاجها ريم كل يوم، أتذكر الكتاب الذي لم أتجاوز نصفه منذ أكثر من شهر، أتذكر الكثير من المشاريع الكتابية التي عليّ أن انجزها.
