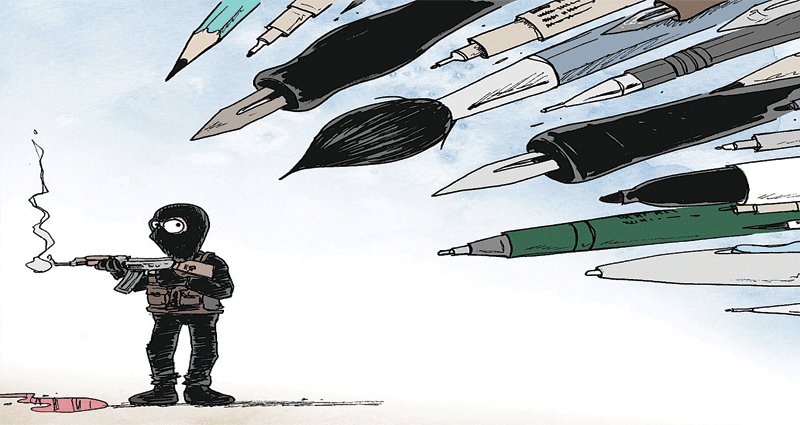
بعبارة أخرى: أطروحات حول الحرية والفكر «3-3»
د. حسن مدن -
لقد جرت الكثير من التحولات المجتمعية التي أضعفت فكرة الحداثة التي انشغل رعيل مفكري الاصلاح والتنوير العرب بارساء مداميكها، وشهدت المدن والحواضر العربية انقلابات ديموغرافية خطيرة، انعكست على بنية الوعي ومظاهره. كانت الحواضر العربية الأساسية: القاهرة، الاسكندرية، بيروت، دمشق، حلب، بغداد، الدار البيضاء وغيرها، قبل أن تدمر الغزوات ألأجنبية والحروب الأهلية الطاحنة بعضها، في بدايات القرن العشرين أكثر جمالاً في عمرانها وتنسيقها، واكثر نظافة في بيئتها، في شوارعها المنفتحة على الشواطئ الممتدة، أو على ضفاف الأنهار، وتتخلل هذه المدن حدائق واسعة جميلة كانت بمثابة الرئة النقية لها، فيما هذه المدن والحواضر ترتد القهقرى عن كل شيء، بما في ذلك منجزها الحداثي الذي صنع ألقها الفكري في بدايات القرن العشرين.
والمفارقة الأكبر، هي أنه من حيث البنية السكانية فإن نسبة الأعمار الفتية في بلداننا إلى ازدياد، لكن هذا لا يترتب عليه بالضرورة نمواً في التفكير الحديث، فالميول المحافظة، هي الأخرى، إلى ازدياد، وحسبنا هنا قراءة طبيعة التحولات التي صاحبت، وخاصةً التي تلت، ما عُرف بالربيع العربي، وما أظهرته من سطوة للجماعات الإسلامية التي هي أميل، بحكم طبيعتها الاجتماعية، وفكرها المنغلق، إلى صنع مجتمع الجماعات المتماثلة، فيما شرط الحداثة هو ضمان التنوع والتعددية.
كثيراً ما ينشغل المنشغلون بالفكر في عالمنا العربي بالموضات الفكرية الآتية من سياقات ثقافية أخرى، غربية في الغالب، أكثر من انشغالهم باقتراح مناهج بحث وتحليل للظواهر الخاصة بسمات وتحولات الواقع العربي، الموضة لا تزيلها سوى موضة أخرى. أشدّ ما تظهر هذه الظاهرة في عالم الأزياء. حين تسود موضة ما يصعب على الجميع عدم مجاراتها. سيغدو ما يرتديه من لم يُجارها من ملابس نشازاً، أو علامة عجز عن مواكبة الجديد. ونضع «الجديد» هنا بين مزدوجين، لأن نظرة على تاريخ الأزياء ستظهر أن ما هو جديد، ليس كذلك حقيقة، إنما هو «تدوير» لموضات سادت في عقود ماضية، ربما لم يدركها أبناء اليوم.
لو أن الأمر وقف عند حدود الأزياء وحدها لهان الأمر. المشكلة أن الفكر والثقافة، هما الآخران، يعانيان سطوة الموضة. حين يسود تيار فكري أو سياسي معين، فإنه يمارس سطوته على الجميع، ويصبح الرافضون له أو المتحفظون عليه ضحايا إرهاب «الوعي» الجمعي المأخوذ بالدرجة السائدة، أو الصاعدة.
في خمسينات القرن العشرين سادت موجة الوجودية في فرنسا، فغدا لها منتدياتها ومنابرها ومريدوها على أوسع نطاق، وبلغ تأثيرها الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، لا في صفوف الأساتذة وحدهم، وإنما الطلبة أيضاً.
الفرنسيون بالذات بارعون في أمر الموضات هذه. ولا همّ إذا أدى ذلك إلى انغلاقهم على أنفسهم، بوجه الثقافات «الآنجلو سكسونية»، لكنهم يقرون بتأثرهم بالألمان، لكن، حتى في هذا، لا يخلو الأمر من نرجسية ثقافية، فهم يرون أن كانط وهيغل وماركس ونيتشه يدينون في شهرتهم لشارحيهم الفرنسيين.
لكن الموضة، أي موضة، حتى لو كانت فلسفية أو فكرية لا تدوم. تأتي موضة أخرى فتزعزع مواقعها وتقصيها عن الواجهة، لا بل تهمشها كلياً أحياناً. فرنسا، أيضاً، هي المختبر النموذجي لذلك. بعد أن أمسكت «الوجودية» بمفاصل رئيسية في الحركة الثقافية هناك، كان عليها أن تخلي مواقعها أمام موضة جديدة صاعدة بقوة، هي «البنيوية»، وحسب تعبير د.جورج زيناتي في تقديمه لترجمته كتاب بول ريكور «التاريخ، الذاكرة، النسيان»، فإنه «فجأة أصبح كل شيء بنيوياً»، لا بل حتى «الفرويدية» و«الماركسية» وجدتا لهما نسخاً بنيوية.
في عالمنا العربي ينطوي الأمر على مفارقة ساخرة. «الوجودية» راجت عندنا، بعد أن انحسرت في مسقط رأسها، حين تعرف إلى بعض مبادئها مثقفونا وأدباؤنا عن طريق الترجمة، يوم تولت «دار الآداب» في عهد مؤسسها د. سهيل إدريس نقل مؤلفات بعض رموزها إلى العربية. سيتكرر الأمر مع «البنيوية»، التي جاءتنا بعد أن كانت فرنسا انعطفت إلى ما بعدها.
ربما آن أوان الكف عن هذا الولع بالموضات الفكرية، لا بمعنى الانصراف عن متابعة الجديد في الفكر العالمي، وإنما بمعنى ألا يتحول هذا هو الشغل الشاغل للفكر العربي، بديلً لاجتراح أدواته المعرفية والحفر في واقعنا الذي ما زال المجهول منه أكثر من المعلوم.
ذات يوم هتف الفنان الشهير فان جوخ قائلاً: «الأغلب أن الحياة مدورة»..! حقاً أنها كذلك. بيد أن مساحة رؤية الإنسان محدودة، فهي لا تتجاوز مائة وثمانين درجة، لذا فإنه لا يرى إلا جزءاً من الدائرة، ويستحيل عليه في آن واحد أن يرى وجوه الدائرة كاملة، لذلك سعى للتحايل على هذا القصور باختراع العدسات المقعرة والمحدبة كي تعينه على رؤية أوسع لما «خلف» الدائرة. نعم! رؤية أوسع أو أكثر اتساعاً. فالواسع نقيض الضيق وقرين الرحابة. كان «باشلار» يقول لو كنت معالجاً نفسياً لنصحت مرضاي بأن يلفظوا كلمة «واسع» برفق، لأنها تجلب الهدوء، وتفتح أمامهم المكان بلا حدود وتجعلهم يتنفسون هواء الآفاق بعيداً عن جدران السجن الوهمية.
في العديد من العواصم والمدن، بما فيها بعض عواصمنا العربية، يخصص الطابق الأعلى في بعض الفنادق أو أبراج التلفزيون ليكون مطعماً بانورامياً، دواراً على الأغلب. وبإمكانك وأنت تتناول غدائك أو عشائك أن ترى المدينة من علو «رؤية بانورامية»، إن صح القول. بعض هذه الرؤية ستأتي فاضحة للمخفي، أو للمنسي. فالزائر لعاصمة ما قد تؤخذ بالانطباع الأولي الذي يعطيه إياه مركز المدينة الأنيق، ولكن «البانوراما» التي تراها من أعلى تكشف لك عن جيوب الفقر ومدن الصفيح والأماكن التي لم تصلها الخدمات. وهذا هو الفرق بين النظرة المجردة السريعة وبين النظرة البانورامية. الأولى سطحية أما الثانية فهي شاملة تُري التناقضات والمتقابلات، الأولى سكونية، أما الثانية فجدلية.
خرج العرب من الصحراء وما زالوا. والصحراء للوهلة الأولى تخلق لديك الانطباع بأنها بانوراما لا متناهية من الامتداد والاتساع، فما بالنا إذاً لا نكون «بانوراميين» في النظرة وفي التفكير والتحليل؟ لماذا يسود لدينا الخطاب الأحادي الذي يغرق في تفصيل من التفاصيل وينسى بقية العناصر والأجزاء المكونة للوحة أو للحدث أو للظاهرة. هل يكون ذلك لأن الصحراء رغم امتدادها فقيرة في التضاريس وفي التفاصيل، بحيث أنها، رغم الامتداد والاتساع، تبدو سطحاً واحداً، جزءاً واحداً، لا مجموعة أجزاء متناقضة؟!
صحيح إن المفكر الذي يشتغل بالتفصيل يرى في هذا التفصيل أشياء كثيرة لا يراها غيره، ولكنه للأسف ينسى أن يرى علاقة هذا التفصيل بما هو أكبر وأوسع وأشمل. نحتاج للبانورامي في الفكر. فلعلنا نبصر أن كبواتنا الحالية ليست سوى تفصيل من لوحة أشمل.
«لقد هرمنا في انتظار تلك اللحظة التاريخية».
مَن مِنا لا يتذكر صورة وصوت ذلك الكهل التونسي الذي كان يمسح براحة يده على شعره الأشيب، وهو يردد بتأثر تلك العبارة، بعيد سقوط زين العابدين بن علي .
حملت العبارة دلالات عدة، بينها أن اليأس كان قد بلغ مبلغه عند النخب السياسية من إمكانية تحريك الجمود الذي طغى على الواقع العربي على مدار حقبة تاريخية كاملة، امتدت عقوداً، بدا معها الأفق مقفلاً بوجه أي تغيير . وحملت أيضاً شعوراً بالغبطة تجاه الجيل الجديد، فما لم تفعله الأجيال السابقة فعله.
كانت تلك لحظة عاطفية استثنائية تبرر مثل هذا الشعور، ولكن الأمر للأسف لم يقف عند حدود حال التأثر هذه، وإنما انبنى عليها وقف متكامل فحواه أن على جميع النخب أن تتقاعد مفسحة المجال للجيل الجديد، الذي أنجز في أسابيع ما عجزت عنه هذه النخب خلال عقود، ولكن تلك كانت طامة كبرى، سرعان ما تكشفت أضرارها الفادحة على كامل مسار التحول العربي، فرموز هذه النخب، وهي تجلد ذاتها، نسيت أن التحولات التي جرت ما كانت ستجري لولا العمل التراكمي الذي قامت به هي نفسها على مدار عقود، سواء في مجال الفكر والمعرفة، أو في مجال العمل الميداني .
ما من تحولات كبرى في العالم تجري من دون أفكار كبرى، من دون نخب واعية . الحماسة حالة انفعالية مؤقتة لا تدوم، أما الفكر فهو ما يمكث في الأرض، ويمهد تربتها للتحولات الواعدة، ومهارة استخدام التقنيات الحديثة التي يتوفر عليها أبناء وبنات الجيل الجديد، لا تعني بالضرورة امتلاكهم الوعي، وإذا امتلكوا هذا الوعي فستنقصهم الخبرة التي يُعتد بها .
