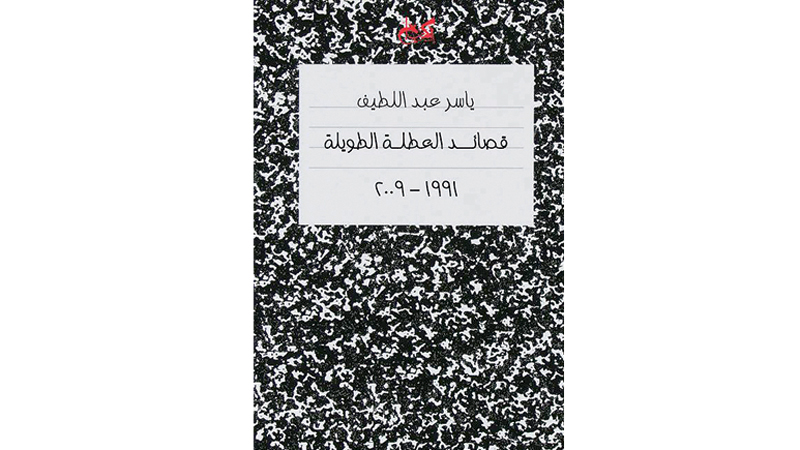
«قصائد العطلة الطويلة».. الحداثة والأنتيكات
حسن عبدالموجود -
رغم المسافة الزمنية التي فصلتْ بين ديواني ياسر عبداللطيف «ناس وأحجار» 1995، و«جولة ليلية» 2009 إلا أن عالمه الشعري لم يشهد انقلاباً، حتى بإضافة بعض القصائد غير المنشورة إلى ديوانه الأحدث الذي يشكل أعماله الشعرية الكاملة «قصائد العطلة الطويلة» يبدو أننا بإزاء شاعر يصنع عالمه على مهل من قاموس لغوي شديد الخصوصية، ومن منظور للعالم والشعر لا يمكن قياسه بالرؤية التي يطرحها كثير من مجايليه التسعينيين، إذ تبقى تجربته شديدة الخصوصية، حتى بالنظر إلى أنه أحد القلائل الذين يجمعون بين كتابة السرد والشعر.
لا يكتب ياسر عبداللطيف وفق وصفة اليومي والعابر، التي روَّج لها الكثيرون على مدار سنوات، والتي جعلت الشعر أقرب إلى قصيدة واحدة يتم تناقلها من كاتب إلى آخر، ومن ديوان إلى ديوان، ومن جيل إلى جيل، قصيدة تعتمد على التداعي الحر، وأفعال المضارع المتتالية، والميل إلى الوصف الرتيب الذي لا يلتقط علاقة، ولا يقيم وزناً للصوت الخاص، حتى وإن كان هذا الصوت نابعاً من قلب الواقع نفسه، يقول ريتشارد دوكنز: إن «الواقع أكثر قدرة على السحر والإدهاش أحياناً من القصص الخرافية»، ولكن هذا يعتمد بكل تأكيد على زاوية النظر وعلى القصة المُلتقطَة وعلى قدرة الشاعر على اكتشاف الدهشة الكامنة في العلاقات. معظم القصائد شديدة القِصر، ويشير إلى ذلك الكاتب الذي بنى عالمه، نثراً وشعراً، على التكثيف، وهو كذلك يملك لغة شديدة العذوبة، تشبه بحيرة صافية تستطيع أن ترى عبر مائها الأحجار والشعاب المرجانية والأسماك الملونة.
يملك ياسر عبداللطيف الكثير من الأفكار عن العالم، الأفكار التي يسرِّبُها بامتداد الديوان عن الحياة والبشر: «البيت كالأوطان والأصدقاء، لا توجد إلا في افتقادها»، «أفريقيا بالكاد تعرف اليونان»، ولكن هذه الأفكار تشبه الماسات التي تلمع فوق سطح شديد الإضاءة، وزاهي الألوان، ذلك السطح يشكِّل الصور التي تخصه، وأغلبها يعتمد على المشهدية، أو السرد القائم على الوصف، كل جملة تشد الأخرى، حتى ينفجر الشعر مع نهاية آخر جملة، إذ أنها آخر مربع في «البازل»، بعدها يمكن رؤية الصورة كاملة. يكتب في قصيدة العجَّان: ««بينما يهجع المخبز الإفرنجي بين ورديتين، وتنام النار في بيتها قليلاً، دفق بوله أصفر ساخناً، في جوال الدقيق المنخول».
إن الجملة الأخيرة في عدد من القصائد تشكل أحياناً ما يشبه المفارقة، كما فعل في قصيدته الجميلة «علم العمران» التي تصِّور ما يفعله العالم المليء بالدنس، بعالم يُفترض أنه عالم القداسة والطهرانية كعالم الراهبات. المفارقة في التلصص الذي يزيح الغطاء عن الأفكار البالية وذلك الاحترام الزائف الذي يبدو كعقد غير مكتوب بين أشخاص الواقع المدنس وملائكة العالم الطهراني:
اقرأ: «لم يكنَّ يعرفن، راهباتُ القلب المقدس، عندما استوطن أرض غمرة بريدانية مصر، أن جسر «باغوص» العلوي، الذي ينحدر صوب الشرابية، سيخترق الأفق أمام نوافذهن العالية، سيكون القمر ساطعاً، عندما يمر أمامه المتسكعون، في ليالي الصيف فوق الجسر الحديث، فرادى وجماعات، ليتلصصوا على العري المقدس».
حتى تلك الصور الأقرب إلى المجاز لا يمكن إحالتها إلى البلاغة التقليدية، بلاغة المزج بين الحسي والمعنوي، بلاغة المضاف والمضاف إليه، إذ أن الصورة تستمد خيالها اللامحدود من عدم معقوليتها، وإدراكنا لعدم حدوث ذلك، وفي نفس الوقت، ويا للمفارقة، رؤيتنا لصورة خيالية شديدة الإبهار.
يكتب في قصيدة «جوع»: «لماذا لا أجرب أن آكل شيئاً جديداً، كخارطة السودان مثلاً، أو آكل دلتا مصر في قطاع طولي، من افتراق الفرعين حتى المصب، بالطمي المتراكم عبر ملايين الأجيال، أو آكل مكتبة هائلة، تغص بالكتب الضخمة عن الروح، أو قاموساً للغة الفرنسية، حتى تطفر الدموع أحرفاً من عيني. لماذا لا آكل امرأة رائعة الجمال، نيئة إلا من أنوثتها! لماذا لا آكل مخزناً كاملاً، لصواميل الصلب الخاصة بالمحركات الثقيلة. لماذا لا آكل حزباً شيوعياً، أو مدينة بأكملها ولتكن دمشق الشام».
يستفيد ياسر عبداللطيف من السرد، لمَ لا وهو أحد أهم الأصوات الروائية التي مهَّدت لظهور كتابة جديدة ومغايرة، بعد حقب من السرد الكلاسيكي، لا ينسى أنه سارد، ولكنه في نفس الوقت لا ينسى كذلك أنه يكتب الشعر، ولذلك فإن السرد يأتي للتخديم على الشعر، ليس مطلوباً الحكاية في حد ذاتها، ولكن الكيفية التي يمكن من خلالها وبأقل عدد من الكلمات تفجير الشعر، ولو من كلام يبدو لوهلة شديد العادية، أو بمعنى أدق، كلام تقريري، يصلح إن تم تدويره لكتابة مقالات! أليست هذه قدرة غير عادية؟! أن تعيد البريق إلى كلمات يبدو وكأن بإمكاننا جميعاً استخدامها وحتى ولو لم نكن أدباء؟! يُسرِّب ياسر عبداللطيف، عبر قصائد الديوان، تصورات عن الذات، بالكاد يمكن من خلالها في نهاية «قصائد العطلة الطويلة» تكوين صورة واضحة لها، الذات الضعيفة لشخص، يترك له رفاقه مهمة حراسة المرمى، وعند إخفاقه فيها يجعلون منه مشجباً لمعاطفهم، الشخص الذي يقطع الوقت في قرض أظافره واحتساء القهوة وتدخين السجائر بلا رغبة حقيقية فيها، الذي يعود إلى البيت منهك القوى، وخلفه مسافات يفقد فيها أشياء لا يذكرها، يرفضه سريره وكتبه، الذي يحاكمه العالم بتهمة عادة التبول في الطرقات رغم أنه لا يفعل. أليس ضعيفاً إلى تلك الدرجة؟! الذي يدفع عن نفسه أي رغبة في الاستقرار، الذي يجرب ويفشل في إقحام ذاته على روح أنثوية ضئيلة، الشخص الذي يميل إلى السير في دهاليز معتمة، بل إنه يُقسِّم حياته إليها، دهاليز النفس، دهاليز المدرسة، دهاليز الجامعة، دهاليز مترو الأنفاق، دهليز مقهى ركس، ومقهى صبحي، وممر زهرة البستان، أو كما يقول: «دهاليز حياته التي قضيتها في الدهاليز»، ذلك الشخص الضعيف جداً، المقيد بأفكاره، وبهواجسه الصغيرة، الراغب في الحرية، حتى ولو بالقفز من الدور الثامن، حالماً بثوان من الحرية، حتى وإن انفجر رأسه بعدها، حالماً كذلك بلحظات من الاهتمام حتى ولو بموته، لحظات يلتف الناس حول جثته يغطونها بأوراق الجرائد، ويلمحون في كل ذلك لحظة ضعف غير مفسرة، شخص يفكر في أنه (يلزم للتراجع اكتساب قسوة جديدة جربت نفسها في فِطرات سابقة وهزائم مختلفة)، الشخص الذي يحتفظ بكراساته المدرسية التي تعكس تطوره الروحي..
إن ذلك الشخص الذي يبدو أكثر قدرة على إظهار نفسه كلما تقدمنا باتجاه القصائد الأحدث لا يتورع عن أن يصف نفسه صراحة في قصيدة «كراسات التاريخ» بأنه ربما يعاني من ازدواجية ما. إنه يفتح كراساته فيستعيد خصوصية ما «أو لأضع بها بعض مسوداتي الجديرة بالحرق، لتكون فهرساً لخيباتي، وسجلاً حافلاً للانتصارات الساحقة، على طواحين الهواء»، إنه شخص كذلك يستطيع تأليف دعابات يبكي الحجر لسماعها، وهو أيضاً ينفجر أخيراً ويتحول إلى قاتل، يقتل هو وصديقه صديقاً آخر، كان ذلك في «نهاية المراهقة».
اقرؤوا تلك القصيدة الجميلة التي تعكس كل خصائص شعر ياسر عبداللطيف، السرد المكثف اللاهث، القدرة على التعبير بأقل عدد من الكلمات، المشهد شديد الوضوح والذي يقترب من كادر سينما سميك وملون، والشعر الذي ينفجر مع آخر جملة، والصورة الكاملة التي يتم تجميعها بكثير من اللقطات الصغيرة، والمفارقة النهائية التي تضيف الكثير إلى المشهد، وترفعه قليلاً فوق الواقع.
«خرجنا ذات ليلة من بيت إحدى المخبولات، ثلاثة مخمورين يذرعون الظلام، انتحلنا صفة ضابط شرطة، وافتعلنا كميناً على طريق سريع، استوقفنا الشاحنات وفحصنا رُخَص سائقيها، وبينما يغادرون بسلامة أوراقهم، انفجرت ضحكاتنا خلف عجلاتهم الكبيرة. وعلى رصيف بوسط المدينة، عثُرنا بكنز من لمبات النيون التالفة ملقاة، العشرات منها هشمناها في نشوة احتفالية، على قرميد الأرصفة، بأحذيتنا، وعلى الأسفلت الخاوي، لفجر القاهرة، لم نبقِ حتى على الشظايا، تركناها كغبار السكر فوق عتمة الإسفلت والقرميد.. وبعدها خفتت حمأة التحطيم، تبخر شيء منا في الهواء إلى الأبد، أسبوع واحد بعدها، وباع ثالثنا نفسه إلى الشيطان، وبقيت أنا والآخر، هو لا يرى، وأنا لا أتكلم، وكقدر المجرمين حومنا في ليلة تالية، حول الحطام، كان دليل إدانتنا القاطع، أذني صديقنا الثالث، بين غبار الزجاج».
تطورت الذات من قصيدة إلى قصيدة، كما تطور كاتبها من الأقدم إلى الأحدث، لم ينسلخ عن عالمه، لكنه ترك قليلاً من وقاره يسقط، ذلك الوقار الذي كان يظهر في قصيدة بها بعض ملامح الإيروتيكا، صار غير مبال بالتورية والإخفاء، كان يكتب بجمال، لكنه تركه إلى جمال آخر. وعلى سبيل المثال أليس الفارق شاسعاً بين هذين المقطعين: «وعند بلوغنا الهاوية، نتبخر أثيراً حتى نُنفش، على الجدار، كأيقونة مسيحية، يطعن فيها تنين، برمح الدهشة، فيسيل دمه الأسطوري علينا»، و« لم تلتق عينانا ككهفين يقبع بهما وحشا الرغبة اللذان لا يستيقظان إلا بالمواجهة، ولم يخل جسدانا بقواعد التلامس المهذب في رقصة هادئة لم نقم بها قط»، أسقَطَ ياسر عبداللطيف الكثير في رحلة تطوره ولكنه كذلك احتفظ بقليل من البلاغة التقليدية «يروض الوقت، جبال الصمت، ودهاليز حياتي»، لكنه كان كالشخص الذي يبني منزلاً حديثاً، ويضع في ركن مميز به قليلاً من الأنتيكات، التي جمعها بنفسه، من عصور سابقة، ومن ثقافات متعددة، وهو يعلم تماماً أنها ستجد من يقدرها كما يقدر كثيرون هذا البيت الحديث.
